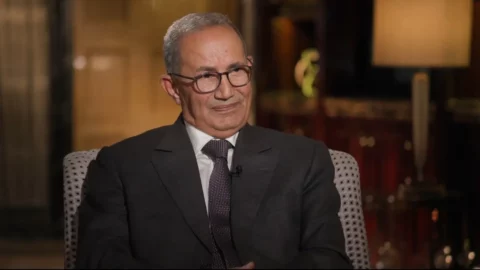فاطمة ضد الظلم.. ضد الهاوية!

في أوقات الغضب الجماعي، يصبح الكلام الهادئ مغامرة، والكلمة المتروية نوعا من المخاطرة. وحين يشعر الناس أن كل قواعد اللعبة تكسّرت فوق رؤوسهم، يصبح أسهل شيء هو أن ننخرط في الجوقة، وأن نزيد حطبا في النار.
لكن هناك دائما قلة عنيدة تختار العكس: أن تمشي عكس التيار، لا لأنها ضد الغضب ولا لأنها متصالحة مع الظلم، بل لأنها تخاف على ما تبقّى من خيط رفيع اسمه إمكان العيش المشترك.
من هذه القلة، اسم واحد ليس غريبا عن المغاربة: فاطمة الإفريقي.
هذه السيدة ليست ضيفة طارئة على معارك الحرية في هذا البلد. بل هي واحدة من أولئك الذين دفعوا ثمنا شخصيا باهظا لمجرد أنهم قرروا أن يكتبوا بضميرهم، لا بأهواء السوق والإعلانات والسلطة.
في حلقة “من الرباط” الأخيرة، لم تغيّر فاطمة الإفريقي جلدها. بالعكس، ظهرت كما عهدناها: متعاطفة بصدق مع حميد المهداوي، معترفة بحجم الظلم الذي تعرض له، وبقتامة الوضع الحقوقي في المغرب، وبحقيقة أن السنوات الأخيرة كانت من أسوأ الفترات التي عاشتها الصحافة المغربية.
قالت فاطمة ذلك بوضوح، لكنها في الوقت نفسه، تجرأت على طرح السؤال الأصعب بشأن القاعدة التي ينبغي أن نخرج بها من هذه القصة: هل الظلم يحوّل الغضب المشروع إلى شيك على بياض يبرّر أي وسيلة، ما دامت الغاية نبيلة؟
البعض سمع نصف الجملة، أو أراد أن يسمع نصفها فقط. ورأى في تنبيهها هذا تقليلا من قيمة ما قام به زميلنا حميد المهداوي، أو حتى اصطفافا مع خصومه.
هذا ظلم مضاعف، والتباس بين ثلاثة مستويات يجب أن نفصل بينها:
- موقفنا من حميد المهداوي وما تعرض له من ظلم؛
- وموقفنا من مضمون ما كشفه الفيديو؛
- ثم النقاش المبدئي حول الضوابط الأخلاقية والقانونية للنشر من حيث هو نشر، بعيدا عن الأشخاص والوقائع المحددة.
لا أحد يملك اليوم أن يشكك في عدالة قضية حميد المهداوي. الرجل استُهدف بشكايات عبثية، وتعرض لمحاكمات سريالية، وواجه حملة تشهير ممنهجة، وطرق كل الأبواب القانونية والمؤسساتية بحثا عن حقه. لكن القضاء لم ينصفه، والمجلس الوطني للصحافة لم يحمه، بل تواطأ ضده، وتحوّل إلى جزء من آلة الظلم.
حين يصل مواطن إلى هذه النقطة، يكون قد استنفد السبل المتاحة، وهنا بالذات اكتسب المهداوي، في نظر كثيرين ومنهم كاتب هذه السطور، شرعية أخلاقية قوية لنشر ما حصل عليه من تسجيلات، لأنها لم تعد مجرد “سبق صحافي” كما يردّد البعض، بل صارت ملاذا أخيرا لكشف منظومة انحرفت كلّيا عن مهمتها.
هل يعني ذلك أن القاعدة العامة التي ينبغي أن نُربّي عليها الوعي العام هي: إذا ظلمك أحد، فصوّره وافضحه، وسينصفك الشارع؟ هنا بيت القصيد.
فاطمة الإفريقي لم تناقش “حق” حميد المهداوي بالذات في النشر بعد كل ما عاشه، بل نبّهت إلى شيء آخر: إن جعلنا من هذه الحالة الاستثنائية قاعدة سلوكية عامة، نكون قد فتحنا الباب واسعا لثقافة الانتقام الفردي خارج القانون، وشرعنّا لكل من شعر بالظلم أن يتحول إلى قاض ومنفذ حكم في آن واحد.
ثم إن هناك التباسا آخر أخطر: كثيرون يتصرفون كما لو أن “جريمة الجرائم” في مثل هذه القصة هي التصوير نفسه. والحال أن القانون، في كل التشريعات، يميز بوضوح بين التوثيق الذي يتم عبر كتابة المحاضر أو التسجيل الصوتي أو المصوّر والنشر.
تصوير الاجتماعات، في حد ذاته، ليس “تشيطين”. وفي كثير من الحالات تُوثّق الاجتماعات واللقاءات بشكل روتيني، في أغلب الأحيان بعد إخبار الحاضرين، وفي أحيان أخرى بشكل ضمني بحكم الأعراف. والمسؤولية القانونية تبدأ عندما ننتقل من خانة التوثيق الداخلي إلى خانة إتاحة المحتوى للعموم.
لنفكر بهدوء:
ما الذي يضر بالكرامة والحياة الخاصة والسمعة؟ وجود صورة أو تسجيل في قرص صلب مغلق، أم بثه على نطاق واسع أمام ملايين الناس؟
القوانين تجيب بوضوح: الإشكال يبدأ عند النشر، لأنه هو الذي يمس بحقوق الأشخاص، ويؤثر على حياتهم المهنية والأسرية، ويصنع أحكاما في الوعي العام لا تنمحى بسهولة.
أما التصوير، فمشكلته القانونية، إن وُجدت، فترتبط غالبا بطريقة إنجازه (هل تم إخبار الناس أم لا؟ هل المكان خاص أم عام؟) وبمسؤولية من حاز التسجيل عن حمايته من التسرب، لكنه يظل قابلا للمعالجة بمساطر أقل قسوة من تلك التي تترتب على نشره.
فاطمة الإفريقي تقول ببساطة: لننتبه إلى أن الرصاصة التي تخرج من فوهة “النشر” لا تعود. وأننا، حين نصفق لفكرة النشر “الانتقامي”، لأنه في حالة معيّنة صادف خصوما “لا نحبهم”، فإننا نُشرعن من حيث لا ندري لواقع مخيف: غدا قد يجد أيٌّ منا نفسه موضوعا لتسجيل مسرّب، يقع بين يدي شخص غير مهني ولا مختص، عكس حالة زميلنا حميد المهداوي، فيُقطع من سياقه، أو يُركَّب عليه ما ليس فيه، ولا يجد أمامه غير جدار الفيسبوك للشكوى.
كثيرون كتبوا تعليقا على الأستاذة فاطمة الإفريقي: “لو كنتِ مكانه لفعلتِ أكثر مما فعل، ولنشرت كل شيء بدون تردد”.
هذا رد فعل إنساني مفهوم. المظلوم بطبعه يتمنى الانتقام. لكن وظيفة القانون والأخلاق المهنية ليست أن تنظم الانتقام، بل أن تحلّ محله.
لم يخترع الإنسان القضاء والمحاكم والهيئات التنظيمية حتى يُرضي رغبة الثأر في النفوس، بل حتى نُخرج الحق من دائرة القوة الخاصة إلى دائرة المعيار العام.
هنا نصل إلى الجرح المفتوح في هذه القصة كلها: ليس في أن حميد المهداوي نشر الفيديو، بل في لماذا وصل، ووصلنا معه، إلى اللحظة التي لم يعد يرى فيها أي جدوى من اللجوء إلى القانون والقضاء والمؤسسات؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن نوجهه، لا إلى فاطمة الإفريقي، بل إلى كل من شارك، بصمت أو تواطؤ أو فعل مباشر، في تحويل منظومة العدالة والتنظيم الذاتي إلى أداة للإذلال بدل الإنصاف.
ماذا فعلتم بهذا البلد حتى جعلتم صحافيا يقضي سنوات من عمره يتنقل بين المحاكم والقاعات والهيئات، ليقتنع في النهاية بأن ما تبقّى له من سلاح هو فيديو مسرّب؟
الذين اتّهموا حميد المهداوي بناء على مزاعم هزلية، والذين سمحوا بمحاكمات لا تقنع حتى تلاميذ السنة الأولى في القانون، والذين أداروا ظهرهم لشكاياته أمام النيابة العامة، والذين حوّلوا لجنة يفترض أن تحمي الأخلاقيات إلى مسرح للسباب والتحقير والتلاعب بالمساطر؛ هؤلاء هم من دفعوا الناس إلى هذا الإحساس المدّمر: لا أمل في القانون.
حميد المهداوي، في هذه الحالة المحددة، حاز، في تقديري، شرعية استثنائية لنشر ما نشره، لأنه أثبت، بالتفصيل والوثائق والشهادات، أنه طرق كل الأبواب ولم يجد إلا الجدار.
لذلك قلت وسأقول إن ما فعله، بعد هذا المسار الطويل من “الاستنفاد”، يقع في خانة الدفاع المشروع عن الحق العام، وليس في خانة الانتقام.
لكن السؤال الذي تطرحه فاطمة الإفريقي، ويجب أن نواجهه بصدق، هو: هل نريد أن يصبح “استنفاد الأمل في المؤسسات” هو القاعدة عند كل مواطن؟ هل قدرنا أن نتحول جميعا إلى نسخ من حميد، كلٌّ يحمل في جيبه فيديو ينتظر اللحظة المناسبة لينشره لأنه لم يعد يثق في القانون؟
جواب فاطمة الإفريقي، وجواب كل من يفكر بمنطق المصلحة الجماعية، هو: لا. الأصل الذي يجب أن نتمسك به هو إعادة الروح للسبل القانونية وللمؤسسات وللعدالة وحياد القائمين عليها.
الأصل أن نُصلح البيت وأن نستثمر هذه الصدمة التاريخية، التي فجّرتها شجاعة المهداوي نفسه، كي نفرض على الدولة وعلى الجسم المهني مراجعة عميقة، لا أن نضيف إلى خراب المؤسسات خرابا إضافيا في الضوابط الأخلاقية للنشر.
وفي لحظة فورتنا الجماعية هذه، اختارت فاطمة الإفريقي أن تقوم بما تجيده منذ سنوات: أن تذكّرنا بوجود الإنسان خلف الخبر، وبأن من نراهم في الفيديوهات، مهما كان سلوكهم مدانا، لهم وجوه وعائلات وأبناء، وأن “قرينة البراءة” ليست مجرد مادة في الدستور، بل ثقافة إذا انهارت، انهار معها كل شيء.
لقد اختارت فاطمة أن تقول ما لا يقال عادة: أن أخلاقيات الصحافة تفرض علينا حماية الهويات حتى في حالة المجرمين المتوحشين، وأن الدفاع عن قضية نبيلة لا يبرر اعتماد وسائل غير نبيلة.
فكرة فاطمة أن الإنصاف لا يكتمل إلا حين نحمي المظلوم من خصومه ومن أنفسنا معا. أن نقف بجانب حميد المهداوي حين يُسحق، وبجانب فاطمة الإفريقي حين تُهاجم لأنها رفضت أن نحرق ما تبقى من جسور الأخلاق باسم التضامن.
قد لا يعجب هذا الكلام كثيرين هذه الأيام. لكن ما فائدة الصحافة إن لم تقل ما يجب أن يُقال في أصعب اللحظات؟ وما فائدة التضامن إن لم يشمل أيضا من يصرّ على أن يذكّرنا، وسط العاصفة، بأننا بشر قبل أن نكون خصوما وحلفاء، وأن كرامة الإنسان ليست تفصيلا ثانويا يُعلَّق عندما تشتد المعارك، بل هي آخر خط دفاع عن إمكانية أن نبقى مجتمعا لا غابة.
لهذا، فإن الوقوف إلى جانب فاطمة الإفريقي اليوم ليس مجاملة لاسم لامع، بل انحيازٌ لضمير مهني نادر، ولامرأة دفعت ثمن نزاهتها من أعصابها وحياتها الخاصة ومسارها المهني، ولم تتراجع خطوة إلى الخلف.
فاطمة الإفريقي من القلائل الذين لا يغيّرون مبادئهم بتغيّر المزاج العام؛ تقول “انتبهوا” حين يكون الجميع مشغولا بالتصفيق، وتضع الإنسان في مركز المعادلة ولو كلّفها ذلك وحدتها في الساحة.
أن يكون في هذا البلد صوت مثل صوتها نعمة ينبغي أن نحتفي بها.
شكرا لأنك هنا فاطمة الإفريقي.