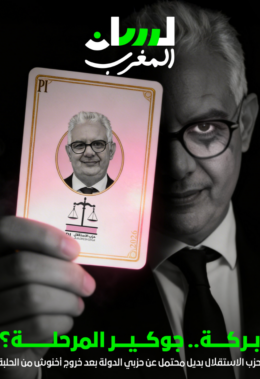نحن.. في قبضة النيوليبرالية!

كاتب هذه الأفكار، لم يعد يرى في صرخة المغربي اليوم مجرد انفعال، ولا عنوانا دعائيا في زمن الأزمات. إنها اليوم حقيقة شعب يتآكل من الداخل، بفعل سياسات تُدار وكأنها صنيعة شركة خاصة، والمجتمع سوقها المفتوح، والمواطن مجرد زبون يشتري خدمات بقدر ما يملك من مال، لا بقدر ما يحتاج أو يستحق.
هذه النيوليبرالية الجديدة، المستوحاة من الفكر الليبرالي المتشدد لفون هايك، أعادت إنتاج الرأسمالية الخالصة على حساب العدالة الاجتماعية، والمساواة، وحتى على حساب الحد الأدنى من الرفاهية التي تحققها الدولة للمواطنين.
لقد عبّر فون هايك بوضوح عن رفضه أي تعديل أو تنازل في رأسمالية السوق الحرة، فهو يرى العدالة الاجتماعية وهما ومفهوما فارغا، بينما يسمي الحرية الفردية قيمة أساسية، يرى أنها المقياس الحقيقي لأي حضارة. وعلى الرغم من أن هذا الفكر يعود إلى القرن العشرين، إلا أن آثاره أصبحت اليوم واضحة في سياسات الخصخصة، وتصفية الخدمات، وإلغاء الدعم عن السلع الأساسية، وتهميش التدخل الاجتماعي للدولة.
السياسات النيوليبرالية التي تُطبَّق اليوم في بلداننا، خاصة على مستوى التعليم والصحة والسكن، لم تترك أي هامش لمفهوم العدالة الاجتماعية أو التكافؤ في الفرص. كما أن الاستشهاد بفكرة السوق العفوي أو “الكاتالاكتيّة” عند فون هايك لتبرير هذه السياسات يشبه تحويل المجتمع إلى كازينو، حيث يُمنح الأفراد الفرصة للمراهنة وفق ما يملكون من موارد، فيما تُترك الطبقات الأكثر ضعفا خارج اللعبة، بلا حماية أو ضمان.
هذا التحوّل ليس مجرد نظرية اقتصادية، بقدر ما هو تجربة يومية يعيشها المواطنون، حيث يُصبح حقه في التعليم أو العلاج أو السكن رهينة قدرة السوق ومزاج المستثمرين.
التجربة التاريخية تُظهر بوضوح أن الرأسمالية الحديثة لم تكن أبدا وليدة العفوية البحتة للسوق، فهي قد قامت على مزيج من القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، بدءا من الثورة الصناعية وحتى ثورات القرن السابع عشر والثامن عشر، التي حاولت الجمع بين الحرية والمساواة. غير أن الفكر النيوليبرالي المعاصر، مستندا إلى فون هايك، يتجاهل هذه المكونات الثقافية والاجتماعية، ويصوغ نموذجا محايدا أخلاقيا للسوق، يحوّل العمل والمجهود البشري إلى رهان على عجلة الحظ، ويهمل دور النضالات النقابية والسياسية في فرض العدالة، مثل مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، الذي ظل مطمحا لم يتحقق إلا جزئيا في مجتمعات العالم الصناعي المتقدم.
إن هذه السياسات لا تؤثر فقط على الاقتصاد، فهي أكثر من ذلك، فهي تمتد لتقويض النسيج الاجتماعي والقيم التربوية. فالعدالة الاجتماعية ليست كما يروج لها سطحيا كشعار، إنما هي الرابط بين حقوق الإنسان والمواطنة، وبين القانون والسياسة، وهي التي تمنح الشباب الإحساس بالانتماء والمسؤولية تجاه وطنهم.
وعندما يتم تحييد الدولة لصالح السوق، ويصبح الحق في التعليم أو الصحة أو الضمان الاجتماعي رهينة قدرة الفرد على المنافسة، فإن النتيجة الحتمية هي تراجع قيم المواطنة، وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، وفقدان الثقة في المؤسسات.
النيوليبرالية وفق هذا المنظور لا تنتج الحرية بالمعنى الذي يفهمه المواطن، إنها تنتج فروقا اجتماعية هائلة، وتحول المجتمع إلى ساحة تنافس مفتوحة على الغلبة المالية والقوة الاقتصادية. كما أنها تعيد إنتاج تصور فون هايك للإنسان باعتباره فردا معزولا، بعيدا عن أي شعور بالعدالة أو التضامن، ليصبح الأقوى هو الفائز، والأضعف هو الخاسر المحتوم.
في هذا الإطار، لا يمكننا التوقف عند التشكيك في العدالة الاجتماعية فحسب، بل يجب التساؤل عن مستقبل قيمنا المجتمعية نفسها، وعن قدرة الدولة على القيام بدورها كضامن للحقوق الأساسية لكل المواطنين.
وإن فهم السياسات النيوليبرالية وفق فون هايك، مع الأخذ بعين الاعتبار نقدها التاريخي والاجتماعي، يتيح لنا قراءة أعمق لأزمة الوطن اليوم. فالأزمة لا تقتصر على سياسات قطاعية أو تقصير إداري، فهي أزمة منظومة قيمية ومعنوية، تتطلب قراءة نقدية لمفهوم الحرية والعدالة والمساواة، ولضرورة إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، باعتباره الركيزة التي يمكن أن تحمي المواطن، وتعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعيد الحياة إلى روح الانتماء والمواطنة الحقيقية.
ومن جهة أخرى، فإن الأزمة لا تقف عند حدود الداخل فقط، فهي تمتد لتتجلى في الموقف من القضايا المصيرية للأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فبينما يتعرض أهل غزة لأبشع صور القتل والحصار، نجد أن منطق النيوليبرالية السياسية والاقتصادية يدفع في اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره فرصة استثمارية أو خيارا استراتيجيا. هنا يتضح أن النيوليبرالية ليست وصفة اقتصادية، بقدر ما هي عقلية كاملة تُقدّم المصالح المادية على حساب القيم والعدالة التاريخية، وتُحوّل حتى المواقف المبدئية إلى أوراق في بورصة السياسة الدولية. إن استمرار التطبيع في زمن الحرب البشعة على غزة ليس سوى امتداد طبيعي لهذا المنطق، الذي يفكك معنى الانتماء الوطني والقومي، ويحوّل الوطن إلى مجرد رقم في حسابات السوق الكبرى.
في المحصلة، يتبين أن ما نعيشه لا يتوقف عن حدود تسيير اقتصادي منحاز، فهو تحوّل بنيوي أعاد صياغة علاقة المواطن بالدولة والمجتمع. وبهذا فالنيوليبرالية تُحوّل الدولة إلى شركة خدمات، والمجتمع إلى بازار، والمواطن إلى زبون، وتفرغ كل القيم المشتركة من مضمونها.
لذلك، فإن معركة استعادة السياسة من هيمنة السوق، وإعادة الاعتبار للعدالة والمواطنة والتضامن، تجاوزت كونها قضية قطاعية أو فئوية، فهي اليوم قضية وجودية تتعلق بقدرة هذا الوطن على البقاء مجتمعا متماسكا، لا مجرد تجمّع أفراد متنافسين في صحراء السوق.