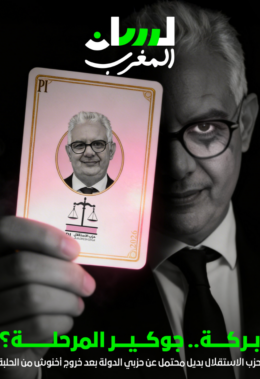جبرون يدافع عن الملك المطلق

من حسنات استقبال برنامج “ضفاف الفنجان” للأستاذ محمد جبرون، عرضه لدفاع واضح عن الاستبداد الملكي، في خطاب قلما نجد نظيره في الصراحة والتكامل والتأسيس المعرفي التاريخي، على ما يستدعيه طبعا من نقاش وتنسيب.
على عكس خطاب القصر، ومنه على سبيل المثال تصريح المستشارين الملكيين، المنوني وعزيمان، منذ خمس سنوات بأن المغرب آت لا محالة إلى الملكية البرلمانية، ولا يخصه لذلك إلا تأهيل الحقل الحزبي، يقول ذ. جبرون صراحة إن الملكية المغربية لا تريد ولا ينبغي لها الذهاب في هذا الاتجاه.
كما أن إحدى خرجاته اللافتة (والموفقة في تقديري) لومه عبد الرحمن اليوسفي ومن والاه على استنكارهم ل”الخروج عن المنهجية الديمقراطية”، معترضا عليهم بأن الديمقراطية لم تكن جزءا من إطار الاشتغال الذي قبلوا به، وبالتالي لا يليق بهم اعتمادها لرفض استغناء الملك عنهم وقتما رأى الأمر ملائما.
ويبقى طبعا من المطلوب نقاش خطاب جبرون في بعض النقط التي تبدو لي مهمة.
أولها انطلاقه مما يبدو كمُسَلَّمة لديه، أن المَلَكية الحاكمة عنده طبع وقضاء وقدر، لا يرى من باب لتجاوزه، إلا توفر شروط تبدو مستحيلة من قبيل خروج المغرب أمن الأمِّية والتخلف وضعف النُخب والمؤسسات وحضور التجاذبات الخارجية.
بل يؤكد أن من يحكم لا يمكنه تقاسم السلطة، وأن الشرعية الآتية من الشعب لا يمكن أن تنافس الشرعية الآتية من لدن الملك، وأن الانتخابات لا يمكن أن تَحُدَّ من سريان الإرادة الملكية.
هكذا تصير نتائج الاستبداد (من تخلف وهوان مقصودين لمنع عصرنة الدولة) مبررا لضرورة استمرار الحكم المطلق دون حتى فتح النقاش عن كلفة الاستبداد وبرنامج ورزنامة الخروج من براثينه، ضدا على المبدأ القانوني الذي يقول إنه لا يمكن لأحد أن يستفيد من منتوج أعماله الدنيئة (Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes).
ويذهب السيد جبرون إلى أن تاريخ مغرب الاستقلال عرف ثلاث مراحل أساسية، الأولى هي مرحلة محمد الخامس، الذي تمكن من تأجيل مطلب عصرنة الحكم دون مواجهات حادة، ثم مرحلة الحسن الثاني إلى حدود الثمانينات حيث، حاول هذا الأخير ممارسة الحكم الفردي قبل أن يرجع لإدماج ورثة الحركة الوطنية، ثم مرحلة الانفتاح والتناوب، حيث قبلت المعارضة القديمة بحمل الأوزار عن الملك دون مزاحمته في السلطة ودون ادعاء غلبة الإرادة الشعبية.
وإذا قبلنا هذا التحقيب، فلا بد من تبيان أن المرحلة الأخيرة لم تكن مرحلة توافق للأنداد، بل مرحلة إخضاع مُذِل، قايض فيه الحسن الثاني عودة الأحزاب إلى الوجود الشرعي وإطلاق سراح أطرها وتمكينها من الصحافة ومن مناصب انتخابية وحكومية صورية (أي أنها لا تمارس حقيقة السلطة)، بشرط قبولها بإطلاقية سلطته. فكان من أذعن للشرط، وكان من قاسى من السجون والمنافي والتهميش.
ومما قد يشكل نقط ضعف في خطاب السيد جبرون أيضا ادعاءه أن الملكية لم تفقد يوما مشروعيتها في عيون المغاربة. وهذا ادعاء غريب من لدن مؤرخ لا يجهل المقاومة الشاملة للاستعمار ضدا على إرادة الملكية، ولا يمكن أن يجهل غياب أي استنكار شعبي للمحاولتين الانقلابيتين لسنتي 1971 و1972.
وأهم ما يستدعي النقاش في كلام السيد جبرون في تقديري هو اعتباره، ككافة مثقفي السلطان في كل زمان، أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، وأن حاكما متجبرا أحسن من سلطة تنبع من صناديق الاقتراع، وأن الحاكم لا يمكن أن يسير ضد مصالح البلاد، وأن على الجميع تقبل كل ما يقوم به لأن له إكراهات لا يمكن تجاوزها.
ويبدو لي أن السيد جبرون يُسقِط على عصرنا هذا فهما للمشروعية يرجع للعصور الغابرة. فمشروعية الحاكم كانت قديما تثبت بغياب القدرة على تحدي سلطته وعلى إسقاطه، وتعتمد هذه المشروعية أساسا على الذعر الذي يتربى عند الرعايا من بطش السلطان.
هذا الفهم لم يعد قائما في الزمن الراهن، ويكفي كدليل أن كافة أنظمة وأساليب الحكم عرفت ما لا يحصى من التغيرات الجوهرية، ولم يخل التاريخ من بنيات كانت تبدو أبدية فإذا بها تتلاشى أو تتهاوى بسرعة عجيبة، ودون أن يهدد زوالها البنيات التي كانت تبدو مرتبطة بها.
وينطبق هذا طبعا على حالة المغرب، حيث يستحيل أن يسود أو يحكم محمد السادس كما ساد وحكم الحسن الثاني أو جده إسماعيل.
خلاصتي من هذا النقاش أن كافة الأنظمة الاستبدادية إلى زوال! هذا ما يبينه لنا التاريخ بالملموس في التطور الحديث للبنيات السياسية، وقد تم هذا الزوال بتوافق مع الملكيات المطلقة ومع الطغم الدكتاتورية أو دون موافقتها، بل أحيانا بالقضاء عليها بشكل عنيف.
لنتذكر قولة “الدولة أنا!” المنسوبة للملك لويس الرابع عشر “Le Roi Soleil”، والتي كانت تعبر عن حالة وثقافة المُلك المطلق في القرن 17، قرنا واحدا فقط قبل إسقاط الملكية في فرنسا وقطع رأس لويس السادس عشر وزوجته.