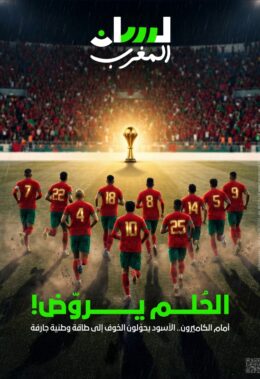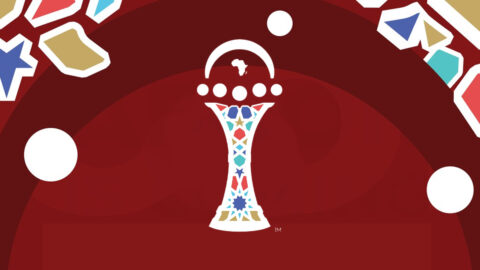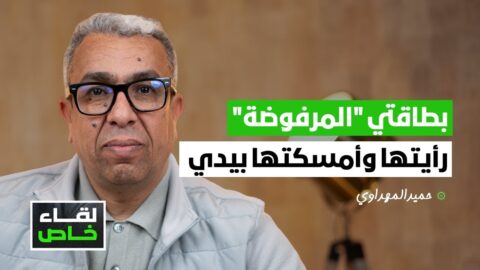5 مفاتيح لفهم الثقافة السياسية لبلد الأئمة والبازار.. تاريخ إيران السياسي بين تورثين

يمكن أن نلخص تاريخ إيران المعاصر في كونه تاريخ حراك اجتماعي لشعب ظل يبحث عن نموذج سياسي يلائم ماضيه وتاريخه العريق، شعب تقلب في النظم السياسية المختلفة، وجرّب أشكالا من النظريات والنماذج في الحكم والتدبير، دون أن يستقر على حال، إلى أن انتهى إلى نظام فريد يدمج بين ثقافته الدينية والسياسية في ولاية الفقيه، عند تأسيس الخميني للجمهورية الإسلامية.
1- بلد الثورات: بين الثورة الدستورية والثورة الدينية ثورة بيضاء
يتمتع الشعب الإيراني بمؤهلات ثقافية وإرث تاريخي وشخصية فريدة جعلت منه محركا دائما للتغير الاقتصادي والاجتماعي. فرغم التنوع العرقي واللغوي الذي يزخر به هذا البلد، فإن دينامية الثورات والتغيير، ظلت تحركه وترجّه عبر التاريخ.
ففي القرن العشرين وحده، يمكن أن نرصد ثلاث ثورات كبرى غيرت المجتمع والاقتصاد الإيراني، وخلقت حراكا اجتماعيا مستمرا تقوده طبقات مختلفة من المجتمع الإيراني. وهذه الثورات ليست سوى امتدادا لدينامية مجتمع يرفض الاستبداد ويسعى باستمرار إلى إيجاد نموذج سياسي واجتماعي يناسب تاريخه ويتمثل حضارته الغنية والمتنوعة.
الثورة الدستورية في بداية القرن: جاءت بين سنتي 1906 و1911، في سياق رفض المجتمع الإيراني للنفوذ الأجنبي والامتيازات الاقتصادية التي منحها البلاط القاجاري للشركات الإنجليزية والروسية، نتيجة لاضطراره المستمر للاستدانة من البنوك الأجنبية، الأمر الذي جرّ البلاد إلى رهن قطاعات اقتصادية حيوية في يد الشركات المانحة، إذ حصل الإنجليز على امتياز التنقيب على المعادن والاستفادة من الغابات وتعمير الأراضي البور ومد السكك الحديدية وحفر قنوات…
ولم تكتف الشركات البريطانية بذلك بل اشترت البنك الإمبراطوري لفارس، واحتكرت سكّ النقود وتحصيل رسوم الطرق، الأمر الذي انعكس سلبا على سيادة الدولة وأضعف نفودها أمام هذه الشركات وألّب الرأي العام ضدها، ووحد صفوف المثقفين ورجال الدين، خصوصا تجار البازار الذين تضرروا من هذه الامتيازات التي منحت للأجانب.
هكذا أغلق التجار حوانيتهم و شاركوا في مظاهرات بقيادة رجال الدين، ومساهمة الحرفيين والطلبة، انطلقت من مسجد شاه عبد العظيم في طهران وكانت تنادي بمجلس للعدالة قائم على أساس تطبيق الشريعة الإسلامية، وإلغاء الضرائب غير الشرعية التي تفرضها الشركات الأجنبية إلى جانب مطالب أخرى اجتماعية.
وقد اضطرت الحكومة القاجارية إلى إرسال الجيش لفتح المحلات التجارية عنوة، لكن المظاهرات انتقلت إلى الميدان الدبلوماسي إذ لجأ التجار إلى السفارة البريطانية واعتصموا فيها، وتشكلت إثر ذلك الحراك، نخبة من القيادات الإيرانية، تعهدت بكتابة مطالب المعتصمين وحملها إلى الشاه، وإنشاء جمعية دستورية تنحصر مهمتها في وضع دستور وطني لإيران لأول مرة في تاريخها.
وقد اضطر مظفر الدين الشاه، إلى قبول مطالب الحركة الدستورية ووقع اتفاقا يتم بموجبه تأسيس الجمعية الدستورية، لتنطلق في ربوع إيران حركة سياسية غير مسبوقة لانتخاب النواب في شتنبر سنة 1907.
لكن المجلس النيابي المنتخب لم يلبث أن دخل في صراع درامي مع حكومة الشاه، انتهى بمظاهرات ومواجهة عسكرية مفتوحة انتهت بتنحية الشاه الذي هرب إلى روسيا، وتنصيب ابنه أحمد ميرزا وتكليف عضد الدولة (رئيس الوزراء) بإدارة شؤون الحكم كنائب للشاه.
الثورة البيضاء: لا يمكن فهم واستيعاب الثورة الإسلامية الإيرانية لسنة 1979 إلا من خلال العودة إلى الإصلاحات التي دشنها الشاه محمد رضى بهلوي سنة 1963، وامتدت إلى لحظة الإطاحة به سنة 1979 فيما يسمى بالثورة البيضاء، وهي عبارة عن سلسلة من المشاريع الضخمة في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية، في الزراعة والبنيات التحتية والصناعة والغابات والمراعي والسدود والري… والهدف المعلن من قبل الشاه هو تحقيق إقلاع اقتصادي ضخم وغير مسبوق، وتحديث البلاد.
لكن الثورة البيضاء في نظر المعارضة كانت مجرد محاولة من الشاه لتفكيك البنية الاقتصادية التقليدية التي تميز المجتمع الإيراني، وتمكين قوى موالية له من الاستيلاء على الأراضي والتحكم في الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد، مع تركيزه على كسب تأييد الفلاحين من خلال استمالتهم على حساب الطبقة الوسطى المعادية له.
فهي ثورة تهدف إلى تأسيس قاعدة شعبية مساندة للشاه في الريف مقابل قطع علاقتها مع الأرستقراطية الدينية والتجارية التي تنشط في المدن.
وقد تم التصويت على الإصلاحات في استفتاء شعبي تم قبوله بأغلبية مطلقة، لكن الثورة البيضاء التي عوّل عليها البلاط البهلوي كاستراتيجية لتعزيز سلطته وكسب مزيد من المشروعية، أدى إلى خلق مشاكل جديدة عوض تجاوز المشاكل التي كان يحاول الشاه معالجتها، فقد خلق طبقة من الفلاحين المستقلين الذين أصبحوا يشكلون ضغطا شعبيا على سياسة الدولة و ممانعة الإصلاحات، كما رمى بمآت الآلاف من المزارعين الصغار الذين باتو بلا أرض يشكلون طبقة بروليتارية معدمة في هوامش المدن.
وهكذا تحولت الثورة البيضاء التي طبقها الشاه لتجنب الثورة الحمراء إلى عامل من عوامل نجاح الثورة الإسلامية، فالانتقادات ضد سياسة الشاه وإصلاحاته المزعومة وجدت من بين شرائح المجتمع الإيراني آدان صاغية، وبتأليب من رجال الدين وتحريض من الفلاحين والمعدمين، انطلقت شرارة الاحتجاجات التي شكلت المساجد محورها والفقهاء مركز دعايتها.
2- التحالف بين تجار البازار ورجال الدين
يعتبر المذهب الشيعي في إيران ديانة الدولة الرسمية، ويحظى فيه الأئمة ورجال الدين بمختلف مراتبهم بمكانة رمزية ومادية مهمة. وقد نجحوا في تعزيز سلطتهم المتنامية بمقوم اقتصادي لا يقل أهمية عن المقوم الرمزي الروحي والأخلاقي، وهو تحالفهم وتعاونهم العميق مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى (البازارات) التي تضم بين تناياها كبار الرأسماليين والسماسرة والتجار والحرفيين.
فخلافا للتمثل المغربي لكلمة بازار التي تشير إلى بائعي التحف في الأسواق التاريخية الموجهة للسياح، فإن الكلمة في سياقها الفارسي تشير إلى السوق بمعناها الاقتصادي كمكان عام لتبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال وسوق الشغل. فهي تشمل تعاملات مالية ضخمة وإيرادات ومعاملات مهمة في بلد ذو كثافة سكانية مهمة، وموقع جغرافي يخول له التصدير والتبادل مع الأسواق القريبة في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الهندية وتركيا.
لذا تمثل البازارات عنصرا أساسيا في السياسة والمجتمع الإيرانيين، ويقوم التحالف التاريخي بين البازار والأئمة على تقديم زكاة المال و ضريبة الخمس والأوقاف للمؤسسات الدينية وليس للدولة، مما دعم صلة رجال الدين بالبازار وجعل كل منهما يساند الآخر ويتبنى نضالاته ومطالبه.
فكما أن رجال الدين ساندو مطالب تجار البازار في الثورة الدستورية لبداية القرن العشرين، فإن تجار البازار موّلوا ودعموا رجال الدين في مطالبهم أثناء الثورة الدينية لسنة 1979.
وتمثل الحوزة العلمية في مدينة قم ثمرة هذا التحالف التاريخي بين رجال الدين والبازار. فهي مؤسسة دينية عملاقة تجمع في جوانبها المجامع الفقهية المتمثلة في صفوة رجال الدين المؤهلين للفتوى والاجتهاد، والطلبة الذين ينتمون إلى مدارس الحوزة العلمية، ويمثلون أدرعها الإيديولوجية والدعائية، ولم يستطع أي شاه عبر التاريخ أن يقلّم أظافر رجال الدين أو يحد من سلطتهم، وذلك نظرا للحماية المتبادلة والتاريخية التي يوفرها التجار ورجال الدين لبعضهم البعض.
فإذا كانت سلطة الدولة تعتمد على التحكم في السلطات وتوجيهها فإن الدولة في إيران ما قبل الثورة الإسلامية، كانت مجردة من السلطة الاقتصادية التي تتجلى في الأوقاف والزكاة لصالح الأئمة، كما أنها مجردة من السلطة الإيديولوجية التي يكتسيها الخطاب الديني لصالح الفقهاء والحوزة العلمية، ما يجعلها أضعف من أن تمارس أدوارها التوجيهية والتدبيرية على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
3- أية الله الخميني ، خيبة أمل غربية
كانت الأنظمة الغربية تعول على نظام آية الله الخميني كحليف بديل لنظام الشاه، فالولايات المتحدة لم تعد راضية عن دور الشاه كشرطي للمنطقة، بل باتت متوجسة من تجاوزه لصلاحياته وتقويضه لاتفاقياتها المربحة مع دول الخليج، ورأت في الخميني بديلا محتملا لشراكة جديدة لا تتجاوز فيها إيران مستواها الإقليمي وفق تعاقد جديد على مقاس تطلعات ومنافع العم سام.
لذلك بدأت تندد بقمع الشاه للحريات وانتهاكه لحقوق الإنسان في تعامله مع المعارضة، كما دفعت مخابراتها النشيطة في طهران إلى منع الجيش من مساعدة نظام الشاه عند احتدام المظاهرات المطالبة بسقوط نظامه، وقد نشطت بريطانيا كذلك في محاربة نظام الشاه وسعت لإسقاطه بعد أن ألغى نظام الكونسورتيوم الذي كان يخول امتيازات عدة للشركات الغربية والبريطانية على الخصوص.
وروّجت الإذاعات الغربية الناطقة بالفارسية أفكار وتحريضات آية الله الخميني، الموجهة للشعب الإيراني عبر موجات الإذاعات البريطانية والفرنسية، كما حث سفير الولايات المتحدة الشاه على الرحيل في إجازة مفتوحة إلى الولايات المتحدة تمهيدا لعودة الخميني من فرنسا، بعد أن تهيأت له الظروف ليصبح رئيسا للبلاد، وذلك ظنا من القوى الغربية أنها يسهل عليها التعامل مع نظام سياسي وليد يحتاج إلى تثبيت أقدامه في السلطة.
لكن العقيدة السياسية للنظام الجديد خالفت كل التوقعات، و استطاعت أن تتجاوز عقبات البداية دون الحاجة إلى حليف، بل إنها ناصبت العداء للغرب مند الوهلة الأولى، و تفجرت أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية لتوضح بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الجديد لا يقبل المساومة، ويصعب ترويضه أو جره إلى أية لعبة سياسية لصالح القوى الغربية.
ففي نونبر من سنة 1979، اقتحم مجموعة من شباب الثورة الإسلامية مقر السفارة الأمريكية واحتجزوا فيها 52 أمريكيا من سكانها كرهائن لمدة 444 يوما، ودعمت الحكومة الإسلامية هذا الاحتجاز واعتبرته عقابا للولايات المتحدة على دعمها للشاه واستضافتها له على أراضيها…
الحاصل أن الغرب أصيب بخيبة أمل إزاء نظام الخميني واعتبره أكثر ضررا من سابقه البهلوي، وهكذا ترسخت لذا الغرب والولايات المتحدة على الخصوص عقيدة سياسية معادية للنظام الإسلامي في إيران.
4- الميثولوجيا الإمامية مقابل الإيديولوجيا السلطانية
تعد الإمامة عند الإيرانيين من أهم أسس المذهب الشيعي، بل إنها أهم ما يميز الشيعة الإمامية عن غيرهم من فرق الشيعة الأخرى، إذ أنها تعتقد أن الله سبحانه و تعالى لا يخلي الأرض من حجة على العباد، من نبي أو وصي ظاهر أو غائب مستور.
كما يعتقدون أن الله أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن ينص على الإمام علي و ينصبه علما على الناس، وأن الإمامة مستمرة في الناس إلى الإمام الثاني عشر (المهدي المنتظر). وطوال مرحلة الانتظار الطويلة للمهدي المنتظر، فإن الشيعة لم يكن أمامهم سوى الفقهاء للاحتماء بهم من الحكام الظالمين.
وقد توّج هذا الاحتماء التاريخي بولاية الفقيه الإمام آية الله الخميني لأول مرة كإمام ورئيس ومرشد أعلى للدولة. واعتمدت تعاليم الشيعة على نظام التقية الذي يتم بموجبه إخفاء أسرار الموقف السياسي للطائفة ضد الأنظمة الحاكمة اتقاء شرها، لهذا تميزت تنظيمات الفرق الشيعية بالسرية الشديدة خوفا من بطش الشاه واستبداده.
كما ترتكز الميثولوجيا الإمامية على أهمية التقليد في المذهب الشيعي، فلا يؤخذ برأي إلا إذا كان صادرا عن مرجع ديني مشهود له بالإمامة والورع، خصوصا من مدينة قم وحوزتها العلمية التي تتمتع بالسلطة المطلقة في الفتوى.
ولفهم الاختلاف العميق في الثقافة السياسية بين الشيعة وأهل السنة، يقدم المفكر المغربي محمد عابد الجابري قراءة تشخيصية لهذا التباين، إذ يرى أن الفكر الإسلامي في الميدان السياسي لم يخرج عن نموذجين أحدهما ميثولوجيا الإمام عند الشيعة وثانيهما الإيديولوجية السلطانية عند أهل السنة.
وإذا كان أهل السنة قد تجندوا للرد على الميثولوجيا الإمامية تكريسا للأمر الواقع، سواء في شكلها القديم أو الحديث، فإن الإيديولوجيا السلطانية التي تتسيد الفكر السياسي عند أهل السنة لم تجد من يتصدى لها.
5- إجماع شعبي على رفض التدخل الأجنبي
تتغير أسماء الثورات وتختلف أسبابها ونتائجها، غير أن الثابت في النسق السياسي الإيراني هو الرفض المطلق والمنهجي للتدخل الأجنبي، إذ نلاحظ إجماعا شعبيا ودينيا على اعتبار أي امتياز اقتصادي أو سياسي للقوى الأجنبية بمثابة خطيئة سياسية لا تغتفر.
ولم تتوحد القوى السياسية الإيرانية المختلفة على شيء مثل وحدتها وإجماعها على ممانعة أي تدخل أجنبي. ولعل الشخصية الرمزية لبلاد فارس الضاربة في التاريخ وموروثها المادي والرمزي الشاهد على الاستقلالية والصمود، خير منبع لهذه العقيدة السياسية التي تعاند التدخل الأجنبي وتعتبره بمنزلة تهديد لوجودها.
فإيران الحديثة هي وريثة تقاليد إمبراطورية فارسية ساسانية جابهت العالم وغزت شعوب الشرق الأوسط وهيمنت شرقا وغربا في موقع مركزي من العالم القديم. وهي كذلك وريثة الدولة الصفوية التي قاومت المد العثماني ونازلته الند للند دفاعا عن عقيدتها ونموذجها الحضاري و الديني.
وحينما نسمع اليوم بعض الأصوات التي تنادي بمقاومة شعبية لاستبداد الحكومة الإسلامية وتحرض الشعب الإيراني ضد النظام القائم، وتدعو قوات إلى الانشقاق عن الدولة التي يحكمها رجال الدين، في سياق الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ندرك الأثر العكسي لمثل هذه الدعوات. فهي لا تؤدي إلى مقاومة النظام أو التشكيك في صلاحيته ومشروعيته، بل على العكس تكسبه مزيدا من المصداقية وتمنحه أسبابا وجيهة للدعم الشعبي، والإجماع الوطني.
صحيح أن هناك معارضة مدنية نشيطة في إيران ضد نظام الحكم الشيعي الحالي، لكنها لا تتجاوز نطاق النضال الحقوقي، الذي تفرضه السياقات الاجتماعية المعاصرة، مثل تمكين النساء وتخفيف الرقابة على الحرية الفردية والتنديد ضد تدخل الرقابة الأخلاقية لرجال الدين في الحياة العامة والخاصة للمواطنين، لكنها لا تتجاوز ذلك إلى حراك اجتماعي لتغيير نظام الحكم، ولا يمكنها أن تشكل إطارا لمعارضة النظام في لحظة التهديد الأجنبي. بل إن مختلف التيارات السياسية على اختلاف مشاربها تجمع على مؤازرة الدولة ضد أي تهديد أجنبي.
فإذا كانت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحصار والحرب قد تدفع الشعوب إلى التذمر والعصيان في مجتمعات أخرى، فإنه على العكس يخلق الإحساس بالتهديد الأجنبي، رد فعل معاكس عند الشعب الإيراني، إذ يمنحه المبررات الكافية لمساندة الكفاح الوطني وتعزيز مشروعية النظام القائم مادام مقاوما للتوغل لأجنبي.
ويتضح ذلك من مجمل اللحظات السياسية الفارقة في تاريخ إيران المعاصر، فالثورة الدستورية ل 1906 ما كانت لتسقط الشاه القاجاري ميرزا نصر الله خان لولا تورّطه في منح الامتيازات للشركات الأجنبية، والأسرة البهلوية ما كانت لتعتلي الحكم إلا في سياق مقاومة التوغل السوفيتي الاشتراكي في إيران، كما أن الثورة البيضاء لم تكن سوى محاولة من الشاه تعزيز شعبيته على حساب تقويض النفود المتزايد للقوى الغربية، أما ثورة 1979 فإنها تقدم ملحمة متكاملة لمعاندة كل ما هو أجنبي غربي على الخصوص.
فبالرغم من إقامة الشاه في فرنسا إلى حين عودته المظفرة، فإن الثقافة السياسية للثورة تقوم بالأساس على استقلالية وتحرر إيران من النفود الغربي. فالغرب هو الشيطان الأكبر الذي ينبغي للشعب والدولة أن تواجهه على جميع الجبهات، بدء بأسلوب الحياة اليومية إلى الإعلام والعلوم والثقافة والفنون. فقد شكلت الثورة قطيعة حادة مع كل ما يمت بصلة إلى الثقافة الغربية ومرتكزاتها الإيديولوجية والأخلاقية.