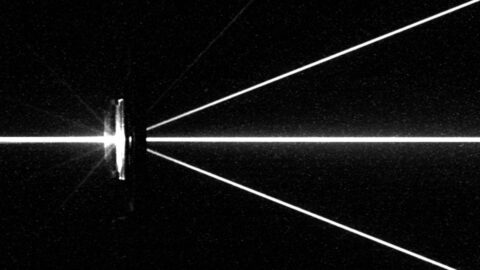من المدينة إلى القرية.. الحراك الاجتماعي يعيد رسم خريطته الجغرافية

يرى مهتمون أن المغرب شهد تحولًا نوعيًا في جغرافيا “الحراكات الاجتماعية”، حيث لم تعد بؤر الاحتجاج تتركّز فقط في المدن الكبرى، كما كان عليه الحال في عقود سابقة، بل أصبحت القرى والمناطق الجبلية والمدن الصغيرة هي منبع الاحتجاجات المعبرة عن الغضب والمطالبة بالعدالة الاجتماعية.
هذا التحول اللافت، الذي تجسّد مؤخرًا في احتجاجات متكررة بإقليم أزيلال، من “مسيرة الأقدام” في آيت بوكماز إلى التظاهرات في دواوير “آيت محمد”، يعكس نقلة عميقة في أنماط الفعل الاحتجاجي بالمغرب، ويطرح أسئلة جوهرية حول الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير.
وفي السياق، أكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي خالد البكاري أن أغلب الحركات الاجتماعية والاحتجاجات في المغرب أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، تتركّز في العالم القروي، وفي المدن الصغرى ذات الطابع الشبه الحضري، فضلاً عن هوامش المدن، حيث تقطن فئات واسعة من المهاجرين القادمين حديثًا من القرى.
واعتبر البكاري في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن هذا التحوّل النوعي في الجغرافيا الاحتجاجية ليس طارئًا، بل يمكن تفسيره بمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها العامل الاقتصادي والتعليمي والثقافي.
الاستنزاف المجالي
وأوضح البكاري أن البادية المغربية، وخصوصًا المناطق الجبلية والواحات، شهدت تدهورًا كبيرًا في أوضاعها الاجتماعية والمادية، نتيجة الاستنزاف الواسع لخيراتها، سواء تعلق الأمر بالثروات المائية أو الغابوية أو الفلاحية أو حتى المعدنية.
وشدّد على أن هذا التدهور لا يمكن اختزاله فقط في عامل الجفاف، رغم حضوره، بل الأهم هو أن هذه الثروات تم استغلالها من قبل فاعلين كبار أعادوا توجيه عائداتها نحو المدن، حيث تُستثمر في مشاريع حضرية، ما عمّق شعور سكان البادية بالتهميش والإقصاء والـ”حُكرة”.
وأضاف: “هؤلاء المواطنون يشعرون أنهم منسيّون، وأنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها سكان المركز، وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة”.
من التعلّم إلى الفعل الاحتجاجي
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن العامل الديمغرافي والتعليمي لعب دورًا محوريًا في هذا التحول، “بحيث أنه منذ تسعينيات القرن الماضي، شهد المغرب تصاعدًا في وتيرة تعميم التعليم العمومي في العالم القروي، وهو ما أتاح لآلاف الشباب، بمن فيهم الفتيات، الالتحاق بالمدارس ثم بالجامعات، خصوصًا تلك ذات الاستقطاب المفتوح ككليات الآداب والحقوق والعلوم”.
وأبرز أن هذا المسار التعليمي مكّن أبناء القرى من الاحتكاك بثقافة نقدية واحتجاجية في الفضاء الجامعي، قبل أن يعيدوا تصديرها إلى مناطقهم الأصلية.
وذكر أن الحركات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق مثل الريف، آيت بوكماز، زاكورة، جرادة، سيدي إفني، فكيك، وغيرها… قادها في الغالب طلبة سابقون وفاعلون محليون متعلمون، إلى جانب حضور قوي للنساء، في ارتباط عضوي بدور المرأة الريفية في الدفاع عن الأرض والماء والعيش الكريم.
الثقافة الرقمية
وأكد المتحدث، من جانب آخر، أن ما ساعد في نقل ثقافة الاحتجاج من المدن إلى القرى هو التحول الرقمي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي لم تعد حكرًا على سكان المدن، بل أصبحت جزءًا من الحياة اليومية حتى في البوادي المعزولة.
واعتبر أن هذا الاتصال الرقمي أحدث تحوّلات عميقة في الأنساق الثقافية وزوايا النظر، وخلق نوعًا جديدًا من الوعي السياسي والاجتماعي، غير مرتبط بالبنيات التقليدية للسلطة أو لوسائطها الكلاسيكية.
وفي تحليله للمقاربات الرسمية، أشار البكاري إلى أن الدولة، خلال فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات، ركّزت على تأمين المدن الكبرى عبر المعالجة الأمنية والإدارية، مثل التقطيع الترابي، بينما ظنّت أن البادية فضاء خاضعا ومستقرا بطبعه، ولم تنتبه إلى التحولات الثقافية والديمغرافية العميقة التي كانت تتشكل بصمت.
وخلص إلى أن خريطة الاحتجاج في المغرب قد تغيّرت جذريًا، وأن انتقال مركز الغضب الاجتماعي إلى المناطق القروية والهوامش لم يعد ظاهرة مغربية فقط، بل يمكن رصدها في تجارب دولية مماثلة، خصوصًا في بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا.
علاقة البادية بالسلطة
وقال الأستاذ الجامعي إن إحدى المقاربات الكلاسيكية التي أثّرت بشكل كبير في فهم علاقة البادية المغربية بالسلطة هي تلك التي صاغها السوسيولوجي الفرنسي غييم لوفو في كتابه الشهير “الفلاح المغربي، مدافعًا عن العرش”، الذي تحوّل إلى مقولة متداولة في النقاشات السياسية والسوسيولوجية بالمغرب.
وأوضح أن هذا التصور، الذي ربط بين الطابع المحافظ للأنساق الثقافية والاجتماعية في البادية وبين خضوعها الطبيعي للسلطة المركزية، أدى إلى ترسيخ صورة نمطية مفادها أن القروي، بحكم بنيته التقليدية، ليس ميالًا إلى الاحتجاج أو العصيان، بل أقرب إلى الولاء والطاعة، في انسجام مع “سلطة محافظة” ترى فيه حليفًا طبيعيًا.
لكن البكاري يعتبر أن هذه النظرة، رغم ما كان لها من وجاهة ظرفية في مرحلة تاريخية معينة، أضحت اليوم متجاوزة بشكل كبير، على ضوء التحولات العميقة التي شهدتها البادية المغربية خلال العقود الأخيرة.
نماذج جديدة للاحتجاج
ومن جهته، اعتبر الأستاذ الباحث في علم الاجتماع بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط علي الشعباني أن التحولات الأخيرة في المشهد الاحتجاجي المغربي لا تقتصر فقط على انتقاله من المدن إلى القرى، بل تتعدى ذلك إلى تغيّر عميق في طبيعة الفاعلين والمنظمين لهذه الحركات.
“فبعدما كانت النقابات والأحزاب السياسية هي من تتولى تأطير الحركات الاجتماعية، أصبحنا اليوم أمام احتجاجات تنبع من القاعدة، تؤطرها تكتلات محلية عفوية، قادها متضررون فقدوا الثقة في الوسائط التقليدية” يقول الشعباني.
وأوضح الباحث أن ما شهدته مناطق مثل آيت بوكماز وأولاد امحمد يعكس هذه الدينامية الجديدة، حيث غاب التأطير الحزبي والنقابي، وبرزت أشكال تنظيم محلية مستقلة عن أي انتماء مؤسساتي.
وأشار إلى أن انهيار الثقة في المنتخبين والسلطات المحلية هو ما فتح المجال أمام بروز احتجاجات جديدة الطابع، كما حدث مع متضرري زلزال الحوز، الذين خرجوا إلى الشارع للتنديد بالتأخر في الاستجابة لمطالبهم، وفضّلوا الاحتجاج الميداني عوض الاكتفاء بالانتظار أو الشكاوى المكتوبة.
وسجّل المتحدث أن “ما نراه اليوم هو تحول بنيوي في سوسيولوجيا الاحتجاج، من تأطير حزبي إلى مبادرة شعبية مستقلة، ومن المدن الكبرى إلى القرى والمناطق الهامشية، ومن الانتظارية السلبية إلى الفعل الواعي والمنظم”، مضيفًا أن ما بدأ في الحوز، ثم انتقل إلى آيت بوكماز وأولاد امحمد، قد لا يكون استثناءً، بل نموذجًا مرشحًا للتكرار في قرى ومناطق أخرى، في حال استمرار غياب التفاعل الجدي مع المطالب.
وأكد أستاذ علم الاجتماع، هو الآخر، أن الاحتجاج لم يعد حكرًا على النخب أو سكان المدن، بل أصبح تعبيرًا شعبيًا شاملًا عن وعي متنامٍ بالحقوق والكرامة، تقوده فئات طالما اعتُبرت صامتة أو مهمشة، مضيفا أن هذا الواقع يجد صدى له في تجارب عالمية، أبرزها حركة “السترات الصفراء” بفرنسا سنة 2018، التي لم تكن مؤطرة حزبيًا أو نقابيًا، بل انطلقت من تكتلات شعبية لمواطنين شعروا بأنهم الأكثر تهميشًا، وهو النموذج الذي يبدو أنه ألهم بعض الحركات الاحتجاجية في المغرب.
وأشار أيضًا إلى أن الاحتجاجات التي نشهدها اليوم في القرى هي احتجاجات نابعة من معاناة حقيقية ومباشرة، من غياب البنية التحتية، انعدام الماء الصالح للشرب والكهرباء، نقص في التعليم والصحة، غياب السكن اللائق، وانعدام الدعم الاجتماعي.
ولفت إلى أن الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي لعبت دورًا في كسر العزلة عن هذه المناطق، بحيث باتت تشكل وسائط فعالة لتوثيق المعاناة ونقلها للرأي العام، مشيرا إلى أن كثيرًا من أبناء القرى الذين درسوا في الجامعات أو يقيمون في المدن أصبحوا فاعلين في هذا الوعي الجديد، عبر مقارنة واقع قراهم بما يشاهدونه ويعيشونه في أماكن أخرى.
واعتبر الباحث الأكاديمي أن فقدان الثقة في البرلمانيين والمنتخبين والسلطات الإدارية، الذين لا يظهرون إلا في الحملات الانتخابية أو عندما تفرض المصالح ذلك، أدى إلى ترسّخ القناعة بأن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن الاحتجاج هو السبيل الوحيد لفرض المطالب الاجتماعية الأساسية.
واشار كذلك، إلى أن التنسيقيات المحلية والتكتلات العفوية التي برزت في هذه المناطق لا تعبّر عن لحظة غضب عابرة، بل عن تحوّل في الوعي السياسي والاجتماعي داخل المغرب القروي، مؤكّدًا أن هذه الحركات تمثل شكلًا جديدًا من الاحتجاج المرتبط بالعيش الكريم أكثر من أي انتماء أيديولوجي.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة التمييز بين نوعين من الاحتجاجات، “الاحتجاجات الحضرية التي غالبًا ما تكون ذات بعد سياسي أو تضامني مع قضايا وطنية أو دولية، في حين أن الاحتجاجات القروية هي ذات طبيعة مطالبية مباشرة، تنبع من الحاجة اليومية وتعبّر عن غياب العدالة المجالية”.
وخلص الشعباني إلى التأكيد على أن القرويين باتوا يتساءلون: “لماذا لا نعيش نحن أيضًا في ظروف تحفظ كرامتنا كبشر؟”، وهو سؤال بسيط في مظهره، لكنه يحمل في طيّاته إحساسًا عميقًا بالحيف والتفاوت.