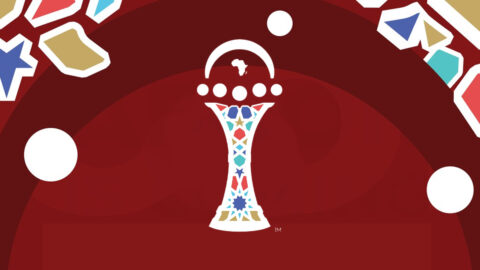زكاة الدولة

أصدرَ المجلسُ العلميُّ الأعلى قبل أيّام فتوى غيرَ مسبوقة في موضوع الزكاة، أحدثت صدمة صامتة في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واندفع معها سيل من الأخبار غير الدقيقة والمغالطات، من قبيل الزعم بأنّ الفتوى جعلت الحدّ الأدنى للأجور موجبا للزكاة.
بعيدا عن التأويلات الجاهزة لأسباب نزول الفتوى وتوقيتِها، وعن شبهةِ استخدامها لتجفيف قنوات تمويل تيّارات دينية مُسيَّسة؛ نحن أمام فرصة لنقاش ضروري طال تأجيله:
كيف تُبنى العلاقة بين الزكاة والضريبة في دولة حديثة لها التزامات عمومية وشرعية دينية؟
وهل تُغني إحداهما عن الأخرى، أم أنّ لكلّ واحدة وظيفة وحدودا لا يقوم بها غيرُها؟
الفتوى نفسها أجابت بالقول إنّ الضريبة «تأخذها الدولة من الناس مقابل مختلف الخدمات التي تقدّمها لهم»، وأنّ الزكاة «يُخرجها المكلَّفون من الأموال حسب أحكامها الشرعية وتستفيد منها الأصناف الثمانية المنصوص عليها».
غير أنّ توصيف الضريبة بوصفها «مقابل خدمات» ليس دقيقا وأقربُ إلى معنى الرُّسوم، لأنّ الضريبة في الفكر المالي العام مورد سيادي تُجبِيه الدولة إلزاما لتمويل السلع والخدمات العمومية المشتركة، أمنا وقضاء وبنيات تحتية وحماية اجتماعية… بصرف النظر عن الانتفاع الفردي المباشر. عكس الرسوم التي تدفع مقابل خدمات معيّنة.
في المقابل، الزكاةُ هي عبادة مالية مُقدَّرةُ الأنصبةِ والحولِ ومحلِّ الوجوب… ومقيَّدة بمصارف محدّدة في كتاب الله. وهذا التباينُ في الطبيعة والمقصد يقطعُ بأنّ دفعَ الضرائب لا يُسقِطُ الزكاة، كما أنّ أداءَ الزكاة لا يُغني عن الضريبة متى اقتضت الضرورةُ العامةُ تمويلَ المرفق العام بعدالة وشفافية ومن دون مزاوجة مُجحفة.
قمت ببحث سريع خلال اليومين الماضيين، ولاحظت كيف حسمت المجامعُ الفقهيةُ المعاصرةُ أنّ الجمعَ بين الزكاة والضرائب جائز عند الحاجة، بشرطِ العدالة في التكليف، ووضوحِ المشروعية والشفافية، وألّا يتحوّل الجمعُ إلى عبء يعطّل المعاش أو يُضاعف الوعاءَ نفسه بلا مسوّغ.
على هذا الأصل ينبني تفصيل عملي لا يقلّ أهمية: الضرائبُ العامّة إذا صُرفت لمشروعات نفعية، لا تُحتسب من الزكاة؛ لأنّها لا تستوفي النيّةَ ولا شرطَ التمليكِ للمستحقّين ولا القيدَ بالمصارف الثمانية المحددة في القرآن الكريم. وبالتالي لا يمكن للمواطن المعاصر أن يزعم أن ما يدفعه من ضرائب للدولة يقوم مقام الزكاة الواجبة دينيا.
الذي يمكن أن يُجزئ ويعفي المرء من واجب إخراج الزكاة هو ما تجمعُه الدولةُ بصفةِ «زكاة» في صندوق منفصل محكوم بالنصّ الشرعي ومراقَب حسابيا، يدفع فيه المكلَّفُ بنيّةِ الزكاة ويبلغُ تمويلُه مصارفَه المعيّنة والمطابقة لما حدّده الشرع.
أمّا في تقدير الوعاء الخاضع للزكاة، فالأصلُ أن تؤدَّى على الصافي عند تمام الحول وبلوغِ النصاب، مع جواز خصمِ الالتزامات الحالّة قطعا، ومنها بعضُ الضرائب المستحقّة في تاريخ الزكاة، أي التي لم تدفع بعد، بينما لا يُخصم المؤجَّلُ غيرُ المستحق.
لكن الأشدُّ إثارة للنقاش في فتوى المجلس هو ما يتّصل بالأجراء والموظفين الذين يتقاضون رواتبَ تفوقُ الحدَّ الأدنى للأجور؛ حيث اعتبرت الفتوى، بعد خصم الحدّ الأدنى باعتباره كفايةَ الضروريات، أنّ الزكاةَ تجبُ في الفائض عند بلوغ النصاب. وهي فكرة ثورية، ولو قال بها منظّر سياسي أو اجتماعي لاعتُبرت ابتكارا بديعا، لأن ما ترسّخ في أذهاننا هو أن الزكاة واجبة على التجار دون الأجراء، علما أن الأجير قد يحصل على دخل أكبر بكثير من التاجر الصغير.
هذا اجتهاد لافت في فلسفته الاجتماعية: يُعفي الضرورةَ ويُلزمُ التضامنَ لحظةَ تجاوزِ عتبةِ الكفاية. وبحسب الأرقام الواردة ضمن الفتوى، فإن النصاب يُقدَّر بقيمة 595 غراما من الفضّة، بما يناهز 7438 درهما، فتجبُ الزكاةُ، برُبُع العُشر، على ما زاد سنويا عن هذا الحدّ بعد خصم الحدّ الأدنى للأجر (3266 درهما شهريا)، وهو ما يعطي حسابيا قرابة 300 درهم ينبغي إخراجها سنويا عن كلّ ألفِ درهم إضافية في الأجر الشهري.
هذه مجرّد حسبة تُيسّرُ الفهم، مع التذكير بأنّ الزكاةَ عبادة تُناطُ بالنيّة والإرادة الحرّة، وأنّ مقصودَها تمتينُ شبكةِ الأمانِ للفئاتِ الثمانية المستحقة للزكاة، لا تحويلُها إلى ضريبة ثانية.
لكنّ الفتوى، بوصْفها صادرة عن هيئة رسمية داخل نظام إمارة المؤمنين، تفتح سؤالا أكبر من تقنية الاحتساب: هل تتجاوبُ الثرواتُ الكبرى مع هذا النداء؟
تقول التقاريرُ الدوليةُ عن توزيع الثروات في المغرب، إنّ 1% من المغاربة يحوزون أكثر من 15% من الناتج الوطني، فيما تنالُ الشرائحُ الأربعونَ الأفقرُ من بين المغاربة 17.4% فقط.
ومع ترسّخ معروف لطبيعة ريعية في قطاعات واسعة، من امتيازات، وحماية من المنافسة، واحتكارات… يصبح سؤالُ «نصفِ العُشر» على أرباح صافية مُتضخّمة سؤالا أخلاقيا وسياسيا معا: هل يقتصرُ نصيبُ ضعفاء الأمّة في تلك الثروات على سهم واحد من أربعين، أم أنّ مقتضى العدالةِ يفرضُ مسارات مكمّلة في الضرائبِ التصاعدية ومكافحةِ الريع وفتحِ السوق للمنافسة، إلى جانبِ زكاة مُؤداة كما شُرِعت؟
ليس المقصودُ أن تحلَّ الزكاةُ محلَّ الإصلاح الضريبي، ولا أن تتخفّى الدولةُ وراءَ عبادة لتسدَّ بها عجزَ الحكامة. المقصودُ أن نُعيد تركيبَ المعادلة على نحو لا يُضلّل الناسَ بشعاراتِ «البديل».
الزكاةُ حق معلوم للفقراء، والضريبةُ واجب مدني لتمويل الصالح العام، والدولةُ إن أرادتَ توحيد القناتين أقامتْ صندوقَ زكاة منفصلا محكوما بالمصارف الثمانية ومفتوحَ الحساب أمام الرقابة، وأقرّتْ في الوقتِ نفسه ضريبة عادلة شفافة لا تُضاعِفُ الأعباء على الوعاءِ نفسه ولا تكافئ الريعَ وتراخي المنافسة.
حينها فقط يُصبحُ خطابُ التضامن مُصدَّقا بالممارسة. لا يُطالِبُ الأجيرَ بما لا يطالِبُ به صاحبَ الاحتكار، ولا يَشدُّ على يدِ الفقير ويُصافحُ يدَ الامتياز.
لقد فتحت الفتوىُ الباب الذي تهرَّبت منه السياسةُ طويلا: كيف نبني منظومةَ عدالة مالية تُصيبُ حقَّ الله وحقَّ العباد معا؟ والجوابُ ليس في التراشقِ بين مَن يختزل الضريبةَ في «مقابل خدمات» ومن يُحوّل الزكاةَ إلى «بديل سيادي»، بل في توزيع دقيق للوظائف.
لابد أن تُؤدَّى الزكاةُ على وجهها وتُصانُ مصارفُها، وتُؤدَّى الضرائبُ على قواعدِ العدالةِ والمقدرةِ والشفافية، ويُفصلُ حسابُ الزكاة عن خزائن الضرائب، وتُكافَحُ أسبابُ اللامساواة في جذورها، من احتكار، وريع، وغيابُ التنافس، والمحاباة.
هكذا فقط يمكننا أن ننتقلُ من صدمةِ الفتوى إلى طمأنينةِ الدولة؛ ومن جدلِ الحساب إلى شرعيةِ التوزيع؛ ومن لاهوتِ «من يدفع؟» إلى سياسةِ «كيف نُوزّع؟».
الحلّ في زكاة تدفعها الدولة عدلا ومساواة وحيادا لا يسقط في السلبية والتغاضي عن اغتناء الأقوياء، وتفقير الضعفاء.