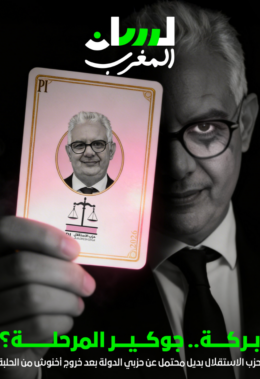رائدنا أمام القضاء

قضية حمزة رائد لم تعد مجرد متابعة جنحية مرتبطة بموجة الاحتجاجات الشبابية، بل تحولت إلى لحظة كاشفة لاتجاهات عميقة تمس بنية الحريات في المغرب، وكيف تتفاعل الدولة مع صعود جيل جديد يعبر ويحتج خارج القوالب التقليدية.
فالحكم الصادر بإدانته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية ومصادرة هاتفه، يكشف توترا بنيويا بين النصوص القانونية القديمة، وروح الدستور، وممارسات السلطة في الواقع الميداني.
يتجلى هذا التوتر أولا في الطريقة التي تمت بها الاعتقالات، إذ جرت قبل الوقفة وبشكل استباقي وعشوائي، أي في غياب تجمهر فعلي يمكن أن يشكل أساسا قانونيا للتدخل. بدلا من أن تتدرج السلطات وفق المسطرة التي يفرضها ظهير التجمعات العمومية—إنذار، تعليل، مهلة للتفريق، ثم تدخل عند الاقتضاء—اختارت مقاربة تقوم على التوقيف قبل أن تتوافر الظروف القانونية للتجمهر ذاته.
بهذا المعنى، أصبح “التفريق” غير مطروح أصلا، لأن ما جرى لم يكن تفريقا بل منعا ميدانيا دون سند إجرائي وقانوني واضح.
تزداد الإشكالية وضوحا حين نعلم أن السلطة لم تصدر أي قرار معلن بمنع الوقفة، مع أن الإعلان ركن جوهري في المشروعية الإجرائية. فالوقفات لا تحتاج إلى ترخيص بمقتضى القانون، وما دامت غير ممنوعة بنص أو بقرار تعليلي مسبق، فإن التدخل لوقفها أو اعتقال من يعتقد أنه سيشارك فيها يصبح خارج الإطار الذي رسمه القانون نفسه.
هكذا تحولت الوقفة من ممارسة مكفولة ضمنيا إلى حالة تعامل كتهديد محتمل يواجه بالاعتقال. هذا المنطق يخلق فراغا قانونيا خطيرا، يمكن أن يفتح الباب أمام تدخلات تقديرية غير مقيدة، ويمس بجوهر دولة الحق والقانون.
هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن النقاش الدستوري الأوسع. فالفصل 29 من الدستور ينص بصيغة قطعية على أن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة. لا يترك النص مجالا للتأويل: الأصل هو الحرية، والقيد هو الاستثناء، والاستثناء بدوره محكوم بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة.
في المقابل، تستعمل في الواقع نصوص قديمة—كظهير 1958 السابق لدستور 2011—تحمل ما لا تحتمل من التأويلات التي تتعارض مع فلسفة الدستور ومع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي لا تجيز أي قيد إلا عند وجود الضرورة والتناسب، ووجود تهديد فعلي ومباشر للأمن العام.
تبرز هذه القضية خللا آخر على مستوى التكييف القانوني. فاعتبار تعبير رقمي أو تفاعل إنساني “تحريضا على ارتكاب جنح” يستند إلى قراءة فضفاضة وغير متوازنة للنصوص الجنائية. التحريض في معناه القانوني يفترض دعوة واضحة ومباشرة إلى ارتكاب فعل مجرم في القانون الجنائي، مع وجود نية موجهة نحو خلق نتيجة غير مشروعة. أما الآراء والتعابير الفنية أو السياسية، فهي محمية دستوريا.
التوسع في تفسير التحريض يفضي إلى تجريم التعبير، ويحول النقد أو التفاعل الرقمي إلى سند للمتابعة، مما يضرب مبدأي الشرعية واليقين القانوني، ويخلق مناخا من الخوف والرقابة الذاتية داخل الأوساط الشبابية.
ولا يمكن إغفال الأبعاد السياسية الأعمق لهذه القضية. فـ“جيل زد” لا يحتج بالطريقة التقليدية، ولا ينتظر دعوات مؤطرة ولا شعارات جاهزة؛ يكفي أن تتشكل قضية رأي عام على منصات التواصل حتى يتحول النقاش الرقمي إلى ضغط واقعي.
الدولة، من جهتها، ما تزال في كثير من الأحيان تتعامل مع هذه الدينامية بمنطق الضبط الأمني بدل بناء قنوات للحوار والإنصات. هذا الفارق بين سرعة التحول الاجتماعي وبطء التكيف المؤسساتي يخلق الاحتكاك الحالي، ويحول كل حدث شبابي إلى اختبار سياسي يتجاوز حجمه الحقيقي.
جوهر النقاش يكشف خللا أعمق: قوانين لم تعد قادرة على مواكبة تطور المجتمع، ممارسات تستبق الاحتجاج بدل تنظيمه، وتأويلات قضائية تعتمد نصوصا قديمة تتناقض مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية. إصلاح هذه الوضعية ضرورة لضمان انسجام المنظومة القانونية مع دستور 2011، وتحصين حرية التظاهر والتجمع باعتبارها حقا لا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود.
قضية حمزة رائد هي حدث معبر يعكس سؤالا معقدا: هل يمكن بناء مستقبل ديمقراطي مستقر إذا ظل التعامل مع الاحتجاج السلمي محتكما إلى أدوات قانونية وسياسية تنتمي إلى زمن آخر؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب إرادة لتحديث التشريع، وتطوير الممارسة، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الشراكة لا الإخضاع، وعلى أساس احترام الحرية لا قمعها.