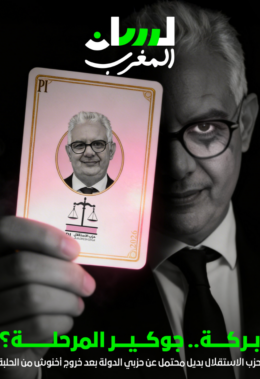خبير: تقاسم البنية التحتية بين المشغلين الثلاثة مفتاح التغطية الشاملة بخدمة “5G” – حوار

شهد قطاع الاتصالات خلال العام الجاري تحولات متسارعة بدأت بإنهاء مجلس إدارة “اتصالات المغرب” لمهام رئيسها التنفيذي عبد السلام أحيزون، بعد أزيد من ربع قرن على رأس الشركة واستبداله بمحمد بنشعبون، الرئيس السابق للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT). تلا ذلك الاتفاق الذي وصف بـ”التاريخي” بين كل من شركتي “اتصالات المغرب” و”إنوي” اللتان قررتا طي صفحة الخلاف الذي دام بينهما والتوصل إلى اتفاق يقضي بتقاسم البنى التحتية للاتصالات من خلال إحداث شركتين مشتركتين.
وفي الـ25 من يوليوز الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن منح 3 رخص إحداث واستغلال شبكات الجيل الخامس (5G) لكل من “اتصالات المغرب” و”أورونج” و”وانا”، بإجمالي 2,1 مليار درهم، معلنة بذلك عن دخول المغرب عصر “الجيل الخامس (5G)” باستثمارات قدرتها بـ80 مليار درهم في أفق سنة 2035.
هذه التطورات تطرح تساؤلات حول مستقبل التغطية الرقمية في المغرب، وعن مدى واقعية الأهداف المسطرة في ظل النموذج التنظيمي الحالي، وكذا قدرة المشغلين الثلاثة (اتصالات المغرب، إنوي، أورونج) على تغطية كامل الحاجيات التمويلية لهذا الورش، خاصة مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.
صحيفة “صوت المغرب” نقلت هذه التساؤلات إلى خالد الزياني مستشار وخبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي أكد أن التحدي الحقيقي يكمن في تغطية كامل التراب الوطني، بما في ذلك المناطق النائية والجبلية، خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير، مشددا على ضرورة إعمال مبدأ التشاركية (mutualisation) في نشر البنية التحتية، وكذا فتح المجال أمام إحداث شركات مستقلة متخصصة فقط في تركيب ونشر البنية التحتية لمختلف خدمات الإنترنت.
وفي ما يلي نص الحوار:
- أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030، تقضي بتغطية 25% من السكان بنهاية 2026، و70% بنهاية 2030. هل تعتقدون أن هذه الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق في ظل السياق الحالي والنموذج التنظيمي؟
كما لاحظنا عقب الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فقد تم الرفع من الهدف الذي حددته استراتيجية المغرب الرقمي مع نهاية سنة 2024، حيث جرى رفع نسبة التغطية المستهدفة بحلول سنة 2030 من 70% إلى 85% من الساكنة.
بخصوص مدى واقعية هذه الأرقام، أرى أن بلوغها يبدو أمرًا سهلا، فمجرد ربط المدن الكبرى المستضيفة لكأس إفريقيا المقبلة في نونبر كفيل بضمان تغطية تفوق 25% من الساكنة قبل نهاية السنة الجارية، وبالتالي تحقيق الهدف الأول في وقت مبكر.
وبالنسبة للهدف المسطر لسنة 2030، فإن نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى أظهرت أن نسبة ساكنة المدن تقترب كثيرًا من عتبة 85%، ما يجعل تحقيق هذا الهدف واقعيًا أيضا.
لكن أرى أن التحدي الحقيقي يكمن في تغطية كامل التراب الوطني والوصول إلى نسبة تغطية 100%، وهو مايتماشى مع الخطاب الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لذكرى عيد العرش، حين شدد على أنه “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين”.
وبالتالي، لم يعد من المقبول أن تحتكر 75% من الساكنة الموجودة في المدن الكبرى جميع الاستثمارات في مجال المواصلات، في حين يتم تهميش باقي المناطق القروية والجبلية، فالهدف المنطقي بحلول 2030 ينبغي أن يكون التغطية لكامل التراب الوطني بشبكتي الجيلين الرابع والخامس، بما يضمن العدالة المجالية.
- في هذا السياق، كيف تقرأون واقع العدالة المجالية في قطاع الاتصالات والتغطية الرقمية اليوم، خصوصا بعد الخطاب الملكي، وهل نحن أمام تقدم أم استمرار للفجوة الرقمية؟
جلالة الملك أثار نقطة مهمة، يجب أن تكون حاضرة بشكل كبير في البرامج الحكومية مستقبلا. ولعل مجال الاتصالات أكثر المجالات الشاهدة على مغرب يسير بسرعتين: مغرب يسير نحو الجيل الخامس (5G) والألياف البصرية (Fibre optique)، ومغرب آخر ما يزال مهمّشًا بالكاد يتوفر على تغطية الجيل الثالث (3G)، أو لا يتوفر حتى على الجيل الثاني (2G).
وبالتالي، بعد الخطاب الملكي صار من الضروري العمل على تعميم التغطية لتشمل كامل التراب الوطني بحلول سنة 2030 بين الجيلين الرابع والخامس، فسرعة الجيل الثالث لم تعد تلبي احتياجات التطبيقات الذكية الحديثة، بينما الجيل الثاني بات متجاوزًا تمامًا، إذ يقتصر على خدمات الصوت دون أن يتيح إمكانيات الولوج الفعلي إلى الإنترنت أو استخدام التطبيقات.
- بالعودة إلى الاتفاق الذي جرى بين “اتصالات المغرب” و”إنوي”، كيف تقرأون هذا الاتفاق في ظل المعطيات الحالية، هل سيخدم المشغلين أكثر أم أنه سيصب بشكل أكبر لصالح المستهلك المغربي، من حيث رفع الجودة وخفض الأسعار؟
هنا سأعود إلى نقطة جد مهمة كنت قد طرحتها خلال السنوات الماضية، وهي أن خفض أسعار الإنترنت يمر بالضرورة عبر فتح المجال أمام إحداث شركات متخصصة فقط في تركيب ونشر البنية التحتية لمختلف خدمات الإنترنت، وهي ما يعرف بمشغلي البنية التحتية، فوجود مثل هذه الشركات سيسمح لمشغلي الاتصالات الثلاثة من تقديم خدماتهم بأسعار أرخص مما هي عليه حاليا.
اليوم نلاحظ أن كل شركة اتصالات تعمل على مدّ كابلاتها الخاصة في نفس الحي، وهذا أمر غير منطقي. فالكابل الواحد قادر على تمرير إشارات جميع المشغلين الثلاثة وبالتالي توفير خدمات الأنترنت بسعر أقل، شريطة أن تكون هناك جهة مستقلة تتكفل بمدّ هذه الكابلات وصيانتها، وتوفر خدماتها للمشغلين بشكل محايد.
المشكل القائم حاليًا هو أن مفهوم “مشغّل البنية التحتية” غير منصوص عليه في القانون، إذ تم منح المشغلين التجاريين (إنوي واتصالات وأورونج) كافة الصلاحيات، بما في ذلك الجزء المتعلق بالبنية التحتية. وبدل أن يفرض عليهم تشارك هذه البنية (mutualisation)، تُرك لهم إحداثها وتدبيرها بشكل منفرد.
في المقابل، ما كان يجب القيام به قبل 10 سنوات هو فصل جانب البنية التحتية عن الجانب التجاري، أي فصل رخص الاتصالات بين ما هو تجاري وما هو تقني، وجعل البنية التحتية مشتركة ومتاحة بطريقة عادلة ومحايدة.
وفي هذا السياق، يُعتبر الاتفاق الأخير بين اتصالات المغرب وإنوي خطوة في الاتجاه الصحيح، بعد أن قام المشغلين بإحداث شركة مختصة فقط بالبنية التحتية الخاصة بالجيل الخامس والألياف البصرية، والتي ستتكفل بعملية تقاسم الموارد بين الطرفين بشكل منظم.
أشير هنا أيضًا إلى مشكل آخر ناتج عن غياب مشغلي بنية تحتية مستقلين، وهو ضعف جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الدولية في مجال الحوسبة السحابية، مثل شركتي “غوغل” و”أمازون”.
ففي دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال، لا يقتصر الطلب على البنية التحتية في قطاع الاتصالات على المشغلين فقط، بل يشمل أيضًا الفاعلين في مجال الحوسبة السحابية، نظرًا للحاجة الكبيرة لمراكز البيانات إلى قدرات اتصالية عالية جدًا. هذا الأمر ممكن هناك بفضل وجود مشغلي بنية تحتية مستقلين يوفرون شبكات مفتوحة (Open Access).
أما في المغرب، فإن غياب مثل هؤلاء المشغلين حال دون جذب شركات عالمية كبرى للاستثمار في السوق المحلية. ففي التجارب الدولية، يقوم مشغلو البنية التحتية عادة ببيع ما يُعرف بـ”الألياف السوداء” (Fibre Noire) سواء لشركات الاتصالات أو لشركات الحوسبة السحابية، مما يخلق بيئة أكثر تنافسية وانفتاحًا.
بينما في المغرب، يفرض القانون الحالي على أي فاعل دولي يرغب في الاستثمار التعاقد مع واحد من المشغلين الثلاثة، وهو ما يشكل عائقًا كبيرًا، لأن هذه الشركات ترفض الارتهان لمنافس مباشر قد يتحكم في خدماتها أو يفرض عليها قيودًا.
- ما أبرز التحديات التنظيمية والتقنية التي تواجه المشغلين الثلاثة اليوم؟ وما التغييرات التي ترى أنها ضرورية لتطوير القطاع؟
أرى أن التحديات الحالية مرتبطة أساسًا بالجانب التنظيمي. وأول ما ينبغي القيام به هو إحداث مشغلي بنية تحتية للاتصالات محايدين، يقدمون شبكات مفتوحة (Open Access). وفي هذا السياق، يمكن تفويض تدبير البنية التحتية للاتصالات إلى الجهات، على غرار شركات الخدمات المتعددة الجهوية (SRM) المكلفة اليوم بالكهرباء والماء والتطهير.
وأقترح أن تتم إضافة خدمة توفير وتوزيع شبكات الإنترنت إلى صلاحيات هذه الشركات، من خلال تعديل القانون 80-20 المنظم لها. فكما يمكن للأعمدة الكهربائية أن تحمل الأسلاك الكهربائية، يمكنها كذلك تمرير الألياف البصرية، وهو ما يُطبَّق بالفعل في فرنسا داخل المناطق القروية.
من هنا، أؤكد على ضرورة تشارك الوسائل (Mutualisation)، حيث تبقى شركات الخدمات المتعددة الجهوية (SRM) الأداة الأنسب لتحقيق هذا الهدف وتمكين المشاركة الفعلية في البنية التحتية.
إلى جانب ذلك، أعتبر أنه من أبرز التغييرات الضرورية فتح المجال أمام شركات الحوسبة السحابية لطلب البنية التحتية مباشرة دون المرور عبر المشغلين التجاريين (اتصالات، إنوي، وأورنج). فأسعار الجملة في قطاع الاتصالات لا علاقة لها بأسعار التجزئة التي يقترحها المشغلون الثلاثة، إذ إنها أقل بعشر إلى أربعين مرة.
كما أن احتياجات الفاعلين في مجال الحوسبة السحابية غالبًا ما تتجاوز قدرات المشغلين الثلاثة مجتمعين، وهو ما يجعل الاستثمار في هذا المجال داخل المغرب مكلفًا للغاية في ظل الوضع الحالي.
لذلك، يجب أن يكون مشغلو البنية التحتية المستقلين قادرين على مدّ شبكات الألياف مباشرة لفائدة فاعلي الحوسبة السحابية أو ما يُعرف بالـHyperscalers. عندها فقط يمكن للمغرب أن يطمح فعليًا إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا لاستضافة البيانات (Hub) على مستوى القارة الإفريقية.
- القيمة الإجمالية للاستثمارات المتوقعة في 5G تبلغ حوالي 80 مليار درهم في أفق 2035. هل تعتبرون هذا الرقم كافيًا لمواكبة حاجيات الرقمنة؟
أرى أن تحقيق تغطية شاملة للتراب الوطني بخدمات الجيلين الرابع والخامس، إضافة إلى الألياف البصرية، يمكن أن يرفع حجم الاستثمارات إلى ما يقارب 100 مليار درهم بحلول سنة 2030، شريطة أن يتم ذلك عبر نموذج يقوم على تشارك البنية التحتية. أما إذا استمر العمل بالنموذج الحالي، فإن الكلفة ستتجاوز هذا الرقم بكثير.
إلى جانب ذلك، من الصعب جدًا على المشغلين الثلاثة وحدهم تحمل هذه الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، مما يجعل من الضروري فتح المجال أمام فاعلين آخرين، وهنا تبرز أهمية الشركات العاملة في مجال الحوسبة السحابية. غير أن ذلك يقتضي أولًا توفير مناخ ملائم للاستثمار لها، وذلك من خلال إحداث مشغلين مستقلين للبنية التحتية، لأن مبدأ التشاركية يبقى شرطًا أساسيًا لضمان النجاعة في تدبير الميزانيات.
أما في ظل الاعتماد على النموذج الحالي للتمويل، فلا يمكننا أن نطمح حتى إلى تجاوز نسبة 50% من التغطية على مستوى التراب الوطني. لذلك من الواجب تطوير النموذج التنظيمي عبر اعتماد مبدأ التشاركية في إنشاء البنية التحتية، وإحداث مشغلين مستقلين، إلى جانب اللامركزية في التدبير نحو الجهات، وتوسيع دائرة الممولين المحتملين.
وباعتماد هذه التوجهات، لن يقتصر الطموح فقط على بلوغ تغطية شاملة بنسبة 100% داخل المغرب، بل يمكن للمملكة أن تذهب أبعد من ذلك عبر المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على مستوى القارة الإفريقية، بالاستفادة من الربط عبر الكابلات البحرية التي تمثل عصب شبكات الاتصالات العالمية.
- من منطلق خبرتكم، ما أهمية الاستثمار في التغطية الرقمية؟ وما الذي نخسره، اقتصاديًا واجتماعيًا، إذا استمر التأخر في تغطية المناطق غير المتصلة؟
الاستثمار في شبكات الاتصالات يعود بالفائدة أولاً على الدولة والساكنة، باعتبار أن الإنترنت أصبح وسيلة لتقريب المسافات واختصار الزمن، حيث لن يعود المواطنون مضطرين للتنقل إلى الإدارات لقضاء أغراضهم، بل يكفيهم استعمال الهاتف للحصول على الخدمات الإدارية بسرعة وفعالية.
وتغطية الإنترنت باتت اليوم خدمة أساسية لا تقل أهمية عن الماء والكهرباء، فضلاً عن كونها تتيح فرصة حقيقية للأفراد للارتقاء في السلم الاجتماعي، بغض النظر عن موقعهم سواء في المدن الكبرى أو بالمناطق القروية.
وعلى المستوى السياحي، يوفر الإنترنت وسيلة للتعريف بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها مناطق نائية في المغرب، مما يمكّنها من عرض خدماتها السياحية مباشرة للعالم، وتحقيق عوائد مادية مهمة.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك قرية تاغية بجهة بني ملال، التي أصبحت وجهة مفضلة لعشاق تسلق الجبال عبر العالم. فرغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 1500 نسمة، لم يتم ربطها بالكهرباء سوى سنة 2015، ولا تزال إلى اليوم محرومة من خدمة الإنترنت.
وهنا يبرز مجدداً مبدأ التشاركية، إذ كان بالإمكان استغلال البنية الكهربائية القائمة لربطها بالإنترنت، ما كان سيمكن ساكنتها من الترويج لخدمات الإيواء والأنشطة السياحية عبر المنصات الرقمية. وبالتالي، كما نرى فإن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب الحكامة الجيدة في تدبير ملف التغطية الرقمية.