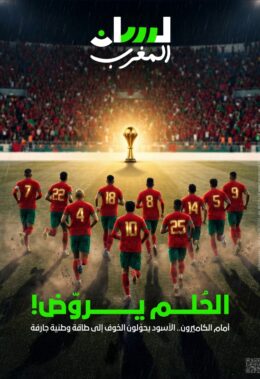حداثة “طوطو” وتقليد “مول الحانوت”

لا أدري لماذا نسقط دائما في المعارك الفارغة والخالية من المعنى والمغزى، كما يصرّ اليوم البعض من خلال النفخ في موضوع لا يعدو أن يكون مجرّد سهرة فنية (سهرة الرابور طوطو)، كان المغرب في عهود غابرة تحت حكم الحسن الثاني يعيش العشرات من أمثالها كل سبت في جل العمالات، ولم يكن الأمر يشغل المغاربة ولا يلهيهم عن مشاكلهم الحقيقية…
“كلها يغني غناه وكلها يشطح شطيحو!”
وأسوأ ما في هذه القصة هو أن نعيش هذا الجدل كمل لو كان تعبيرا عن صراع الحداثة والتقليد، كما يتوهّم البعض، بينما تجري المعركة الحقيقية في عالم الاقتصاد والرأسمال والأسواق، بما في ذلك المعركة بين “القديم” و”الجديد”.
فبينما تُشعل هذه الجدالات معارك رمزية وهوياتية فارغة، نُغفل النقاش الحقيقي حول التحولات العميقة التي تمس بنية عيشنا اليومي، والتي يقدم تقرير مجلس المنافسة حول مسالك توزيع المواد الغذائية، مثالا واضحا عليها من خلال معطيات دقيقة ودالّة.
في الواقع اليومي للمغاربة، لا شيء يكشف مستوى العيش واستقراره، ومدى اقترابنا أو ابتعادنا عن منطق التحديث، أكثر مما تكشفه الطريقة التي نُزوّد بها بيوتنا بالطعام.
وخلف عملية بسيطة مثل اقتناء الخبز أو الزيت أو الخضر، تختبئ منظومات كاملة من الإنتاج، والتخزين، والنقل، والتسعير، والتوزيع، والعلاقات بين الحلقات الوسيطة، وهي كلها انعكاسات دقيقة لبنية الاقتصاد، ولأنماط السلطة، ولمدى احترام قواعد المنافسة، ولسيادة القانون أو تغوّل منطق الريع والاحتكار.
فالمسألة ليست ترفا استهلاكيا ولا امتدادا لنقاشات هوياتية بيزنطية حول الأصالة والحداثة، بل هي عصب من أعصاب الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، والثقة في الدولة والسوق على السواء.
من هنا، فإن مقارنة مسالك التوزيع التقليدية والعصرية لا تنطلق من ثنائية صدامية بين قديم وجديد، وإنما من حاجة ملحّة لتفكيك منظومتين تتعايشان أحيانا، وتتنازعان أخرى، داخل واقع اقتصادي واحد، ومتطلبات مجتمعية تتزايد تعقيدا.
التقليدي في هذا المجال ليس مجرد موروث عتيق. والبقالة ليست أثرا من الماضي ولا كيانا فلكلوريا، بل ما تزال تمثل القناة الأساسية للتزود الغذائي لشرائح واسعة من المواطنين، سواء في القرى أو الأحياء الهامشية للمدن.
“مول الحانوت” ليس تاجرا فقط، بل هو فاعل محوري في توازنات الحي، ويلعب أدوارا تتجاوز منطق السوق الضيق: يمنح القروض، ويقدّر ظروف الأسر، ويشتري بضاعة يعرف أنها لن تُباع إلا آخر الشهر، ويقوم أحيانا بدور الوسيط بين الجار وجاره في الصلح وتجاوز الخصام…
لكن هذا النظام في توزيع المواد الغذائية، ورغم دفئه الاجتماعي، يعاني من اختلالات بنيوية لا يمكن التغاضي عنها.
فهو نظام يفتقر في الغالب إلى التبريد، وإلى تتبع الجودة، وإلى الرقمنة، وإلى الشفافية الضريبية، وإلى شروط المنافسة العادلة.
إنه نظام هشّ، يسير بفضل العرف والثقة، لكنه لا يصمد كثيرا أمام صدمات السوق، ولا أمام تقلبات العرض وأسعار الجملة، ولا أمام فجائية الأزمات كما أظهرت جائحة كورونا.
في المقابل، تقدّم مسالك التوزيع العصرية نموذجا مناقضا من الأساس: فضاءات استهلاكية ضخمة، وتنظيم محكم، وسلاسل تبريد حديثة، ورقمنة في التتبع والتخزين، وقدرة على الشراء بكميات ضخمة، ثم توزيع وفق خطة تسويق محسوبة.
هذه المسالك تمكّن من تقديم منتج موثوق نسبيا من حيث السلامة الصحية والتاريخ والتعليب، كما تتيح للمستهلك خيارات متعددة في مكان واحد، وتمنح إحساسا معقولا بالشفافية والثقة.
غير أن هذا النموذج، رغم وجاهته التقنية، لا يخلو من أعطاب أخرى:
فهو يُقصي الصغار، ويكرّس منطق السوق الكبير الذي يبتلع كل شيء، ويحوّل العلاقة بين المواطن والطعام إلى علاقة باردة، عددية، خالية من أي بُعد اجتماعي أو تفاوضي. الأسعار تُحدد مسبقا ولا تترك مجالا ل”الشطارة”، والعروض تُصمَّم بذكاء نفسي، ولكن العلاقة الإنسانية التي كانت تحمي المستهلك الضعيف من السوق الشرس، تتلاشى.
الأهم من ذلك أن النموذج العصري غالبا ما يُبنى في مناطق جغرافية مختارة، ويستهدف طبقات اجتماعية محددة، ما يجعل منه مدخلا جديدا للتمييز واللاعدالة المجالية.
وفي الوقت الذي يتباهى فيه المركز التجاري بنظافة الممرات وتعدد العلامات، تظل الأحياء الهامشية والبوادي رهينة للتزود العشوائي، ولسوق غير منظمة لا تُراقَب فيها الجودة ولا تُحمى فيها الحقوق.
لذلك، فإن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يكون حول “الهويات الغذائية” أو “حنين البقالة” أو “إبهار المركز التجاري”، بل حول بناء نموذج وطني بديل، يجمع بين قوة الروابط الاجتماعية التي يضمنها التقليدي، وفعالية التنظيم العصري، دون أن يقيم تراتبية إقصائية جديدة.
نحن لا نحتاج إلى إبادة “مول الحانوت” كما لا نحتاج إلى تقديس “السوبرماركت”، بل نحتاج إلى جعل الأول أكثر قدرة على التحديث، والثاني أكثر قدرة على الإدماج، ليخدما معا المواطن لا أن يتنافسا على جيبه.
من هنا، يصبح الإصلاح في هذا المجال رهينا بإجراءات عملية:
دعم البقالة من أجل الرقمنة، وتحديث أدوات التخزين، وتوفير التمويل الصغير، وإدماج الفاعلين التقليديين في منظومات الجودة والرقابة؛ في مقابل إلزام الفاعلين العصريين بسياسات الإدماج المحلي، والتزوّد من الفلاحة الصغيرة، وإعادة الاعتبار للاقتصاد القريب من الناس.
إن مائدة المغربي لا ينبغي أن تصبح ساحة حرب بين نموذجين، ولو تحت شعار التحديث والتقليد، بل هي فضاء تعايش وتكامل، لأن الغذاء ليس مجرّد سلعة تُستهلك، بل هو فعل مواطنة، ومجال للسيادة، وحق اجتماعي ينبغي أن يُدار بأدوات الاقتصاد، لكن أيضا بحكمة المجتمعات.
الحداثة التي نريد هي تلك التي تجعلنا نعيش حياة بها جرعة كرامة، ومساواة أكبر، وتجعلنا نأكل غداء أنظف وأقرب إلى طعام بني البشر الذين نجاورهم في الضفة الشمالية للمتوسّط.
الحداثة التي نريد ونستحق، ليست كما يتوهم البعض، أن تنجح في تنظيم سهرة لفنان وتقدّم ذلك على أنه إنجاز سياسي ونصر على الخصم “الظلامي”.
الانتقال الحداثي يعني قبل كل شيء، بناء علاقة عقلانية مع الذات والمجتمع والمؤسسات.
ووثيقة مثل تقرير مجلس المنافسة، يوفّر لنا مادة دسمة لفهم شكل آخر من التحول العميق، والانتقال من القديم إلي الجديد، ذاك الذي لا يُطلق الشرارات على المنصات، بل يتغلغل في تفاصيل العيش اليومي:
كيف ننتج غذاءنا؟
كيف نوزعه؟
من يتحكم في الأسعار؟
ومن يُقصى ومن يُحتكر؟
إنها أسئلة الحداثة الفعلية التي لا تدور حول من يصعد إلى الخشبة، بل حول من يسيطر على رفوف المتاجر، ومن يملك القرار في مسارات الغذاء، ومن يحدد علاقة المواطن بالمجال والأسواق والسوق.
والاختلال الحقيقي لا يكمن في “تقليدية” هذا الطرف أو “عصرية” ذاك، بل في غياب التكامل، وفي هشاشة القواعد الناظمة للمنافسة، وفي استقالة الدولة من دورها التوجيهي والتحكيمي.
وما يشير إليه تقرير مجلس المنافسة بوضوح، هو أن التوزيع الغذائي ليس مجرد قطاع خدمات، بل هو ركيزة للأمن الغذائي وللعدالة الاجتماعية وللسيادة الاقتصادية. وحين تغيب الرؤية المندمجة، وتترك السوق وحده يقرر، فإن النتيجة تكون دائما على حساب الطرف الأضعف: المواطن.
فهل نحن، من خلال انتقالنا التدريجي من مسالك تقليدية إلى مسالك توزيع عصرية، نكتسب شيئا من عقلانية الحداثة وشفافيتها ونقدها؟
أم أننا لا نقوم سوى بإلباس ماضويتنا رداء حديثا، نُعيد فيه إنتاج الاحتكار واللاعدالة والمحاباة نفسها، ولكن تحت إنارة أقوى ورفوف أكثر ترتيبا؟
أخشى أن هذا هو بالضبط ما ينبئنا به هذا التقرير، على الأقل عندما يجزم بالطابع الاحتكاري في مجال الأسواق العصرية لبيع المواد الغذائية.
وهذا هو النقاش الذي يستحق أن نحتدّ فيه، لا عن صعود “طوطو” إلى منصة مهرجان أو عدد اللذين “هتفوا” خلفه.