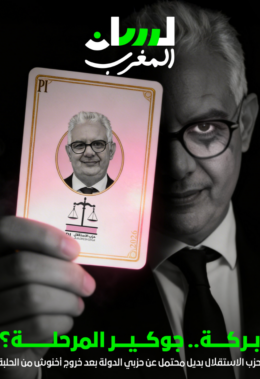جيل “كليناهم”.. تتويج «أشبال الأطلس» لحظةٌ مغربيةٌ (قد) تتجاوز الملعب

في مساءٍ رباطي واحد، كانت المدينة تمشي على ساقين مختلفتين. من باب السفراء خرجت الحافلة الحمراء المكشوفة، تعلوها عبارة «أبطال العالم»، يتدلّى منها العلم ويتلوّى الهتاف على طول شارع محمد الخامس حتى ساحة البريد.
نفس اللحظة، وعلى مسافة ليست بعيدة، كانت قاعةٌ في «قصر العدالة» تعلن أولى الأحكام في ملفات شبّانٍ من “جيل Z” اعتقلوا في الرباط، إثر احتجاجات أواخر شتنبر.
لم يكن الأمر تزامناً يصلح للزينة البلاغية؛ بل كان إطاراً زمنياً ضاغطاً يكشف كيف تتدفّق الطاقة الاجتماعية ذاتها عبر قناتين: ملعبٌ صقلها فأنتج نتيجة عالمية في سانتياغو، وشارعٌ عبّر عنها في شكل مطالب اجتماعية مباشرة تتلخّص في صحةٍ تُطمئن وتعليمٍ ينهض وكرامةٍ لا تُهان.
بين الحافلة التي تشقّ موج الجماهير ولحظة النطق بالحكم، ارتسم سؤال المعنى العام: بأي أدوات تُدير الدولة لحظة اعتلاءٍ رمزي وصعودٍ شبابي؟
وكيف تُترجم سردية الفوز من لغة بهجةٍ إلى لغة مؤسسات قابلة للقياس حتى لا تذوب في حرارة الاحتفال؟
جيل ولي العهد
تفاصيل المشهد قدّمت المفتاح الأول. الاستقبال الذي ترأسه وليّ العهد الأمير مولاي الحسن، بتعليماتٍ ملكية، لم يكن مجرّد بروتوكول؛ بل كان وضعاً للتتويج داخل إطارٍ جيليٍّ دقيق: شابٌّ من الجيل نفسه يستقبل أقرانه، في قصرٍ صار في تلك الأمسية امتداداً رمزياً لأكاديميةٍ ومراكز تكوينٍ وشبكات كشفٍ ومختبرات أداء.
كانت الصورة تقول إنّ سياسة التكوين لم تعد ملحقاً ثانويا للرياضة، بل قناةً من قنوات إنتاج الكفاءة الوطنية، حيث تُستثمر الموارد ويُحترم المسار وتُحصّل النتيجة. وفي المرآة المقابلة، جاءت الأحكام الابتدائية في الرباط لتطلق إنذاراً مؤسساتياً دقيقاً: الرسالة العامة تتعرّض للاهتزاز حين يُقرأ التعبير السلمي بأدواتٍ قانونيةٍ وُضعت قبل العصر الرقمي وقبل دستور 2011، وحين يتحوّل الاعتقال الاحتياطي من ضمانةٍ إجرائية إلى عقوبةٍ عملية.
هنا لا تمسّ القراءةُ استقلال القضاء، بل تضع إصبعها على السياسة الجنائية بصفتها البوصلة التي تُنظّم الممارسة القضائية اليومية وتضبطها على إيقاع الحقوق والحريات وروح الاستجابة العمومية التي برزت في مخرجات المجلس الوزاري ليوم الأحد 19 أكتوبر 2025.
وإذا كان الشارع قد صفق للكأس حتى دوّى النشيد، فقد صفق أيضاً لقراراتٍ عمومية ثقيلة المعنى، مثل رفع المجهود الميزانياتي في الصحة والتعليم، وفتح آلاف مناصب الشغل، وتسريع أوراش المستشفيات الجامعية، وتسريع خارطة طريق إصلاح المدرسة…
هذه الاستجابة تقول ببساطة: «سمعنا الرسالة»، وتحوّل الفوز من حدثٍ رياضي إلى برهانٍ تنفيذي على قدرة الدولة حين تتوحّد الإشارات. لكن اكتمال الرسالة يشترط انسجام الطبقات كلّها: أن يظلّ النهج على لحن الاستثمار في الجيل، وأن تتمايل الحكومة على لحن التنفيذ، وأن تُضبط السياسة الجنائية على الايقاع نفسه، حتى لا تصعد من قاعة المحكمة نغمةٌ شاذة تُربك السيمفونية.
وما يجعل هذه اللحظة مركّبة بحقّ، هو أنّ طرفَيها ينتميان إلى الجيل نفسه: اللاعب الذي تعلّم الانضباط التكتيكي وعلوم الأداء والاشتغال ضمن منظومة واضحة القواعد، والمتظاهر الذي تمرّن على أدوات التعبير السلمي والرمز والتجميع الرقمي.
كلاهما يطالب بالقواعد نفسها: تكافؤ الفرص، ووضوح المساطر، وتناسب القرار مع الفعل.
سردية التتويج
لم يكن لقب سانتياغو نيزكاً عابراً في سماء كرةٍ متقلبة؛ بل كان حلقةً مضافة في سلسلة بدأت قبل سنوات، يوم تغيّرت فلسفة العمل من تجميع مواهب متفرقة إلى بناء مسارٍ سنيّ متدرّج له بوابات دخول ومعايير عبور وآليات تغذية راجعة.
لقد عبر منتخب الأشبال «مجموعة موت» تعمّدت فيها الأعصاب قبل الأقدام، ثم عبر أدوار إقصائية ضيّقة الهامش أمام مدارس كروية مختلفة، وتَكثَّف درس المنهج أكثر من درس النتيجة.
وتمنح القراءة التقنية الأولى علاماتٍ واضحة: كتلة دفاعية تعرف متى تنكمش ومتى تندفع، وحارس يحوّل الثواني الحرِجة إلى فائض طمأنينة، وتوقيت هجومي مبكّر يخفّف ضغط المطاردة ويقلب المعادلة النفسية.
لكنّ القيمة المضافة الحقيقية لا تقف عند دفتر التكتيك؛ بل هي في قابليّة تحويل ما جرى على العشب إلى أسئلة مؤسسية خارج الملعب: كيف بُنيت هذه الجهوزية؟ وأيّ التزامات في التكوين والانتقاء والقياس سمحت بتحويل هذا الجيل إلى نتيجة قابلة للتكرار، لا إلى ومضةٍ يتيمة؟
حين قال مايسترو منتخب الأشبال، محمد وهبي، إن «الهدف كان أكبر من تقديم كرة القدم وحدها»، بدا كمن يلخّص وثيقةَ مشروع أكثر مما يطلق جملة ما بعد النهائي. فخلف العبارة تكمن منظومةٌ تعلّمت من مصادر متعدّدة: أكاديميةٌ محلية رفعت معيار الاختيار والتدريب البدني، وبيئةُ مهجر صقلت الانضباط التكتيكي وعلوم الأداء، وجهازُ متابعةٍ يربط الموهبة بمسار محدّد فلا يترك كثيراً للصدفة.
هذا التزاوج بين مدرسة الداخل ومدرسة الخارج لم يُنتج «استقدام أسماء»، بل حوّل رأسمالاً بشرياً موزّعاً إلى قيمةٍ مضافة داخل مخططٍ وطني، تُقاس فيه الدقائق والأمتار والنبضات، وتُترجم فيه البيانات إلى قراراتٍ يومية.
هنا يصبح اللقب خاتمة فصلٍ وبداية فصلٍ آخر: ما دام كلُّ عنصرٍ في السلسلة مفهوماً ومُمأسساً، فإن النتيجة لا تعود رهينة الظرف؛ فتتعاقب الأجيال ولا يتغيّر المنحنى.
لم تغيّر الصورة الملتقطة داخل القصر الملكي، بتعليماتٍ ملكية واستقبالٍ أميري لأقرانٍ في العُمر، المعنى الرياضي، بل كمّلته بإشارة رمزية ذات وظيفة مؤسسية. لم يعد النسق الرمزي مفصولاً على طريقة «دولة» في الأعلى و«شباب» في الأسفل؛ وبات الامتحان يُجرى في ساحةٍ مشتركة، عنوانُها مؤسسات التكوين والانتقاء والمواكبة.
بهذا الترتيب، تغادر الكأس خانة الفرجة إلى خانة «القدوة الإجرائية». فعندما تُجهَّز المنظومة جيداً تُنتج نتيجةً عالمية، وعندما تُعلَن قواعد اللعب مسبقاً يصبح القياس ممكناً والمساءلة طبيعية. والصورة لا تكتفي بتسويق الفخر، بل توفّر معياراً عملياً يُسأل به الجميع:
ما الذي يضمن استدامة التدفق من القاعدة إلى القمّة؟ أين تتراكم الخبرة وأين تتسرّب؟ وكيف تُموْضع الموارد بحيث تخدم المسار لا العنوان؟
يفرض تحويل التتويج إلى أداةٍ لا غايةٍ نقل مفردات الملعب إلى قاموس السياسات. الانضباط التكتيكي خارج العشب يعني وضوح الأدوار وتوزيع المسؤولية بين الفاعلين من أكاديميات وأندية وجامعة وأجهزة رياضية، وصلابة الدفاع تُشبه منظومات التدبير التي تحمي المسار من الارتجال، ويقظة الحارس ترجمتها أنظمة إنذار مبكّر تلتقط الأعطاب وتُصحّحها قبل أن تستفحل.
أما الحلول الهجومية المبكّرة فتقابلها جرأة القرار في فتح مسارات التدرّج وتوسيع قاعدة الانتقاء، وعدم ترك المواهب تتساقط في الفجوات الاجتماعية والجغرافية. بهذه اللغة يصبح اللقب مختبراً لمعادلةٍ يمكن تعميمها: استثمارٌ متّسق في البنية التحتية الناعمة والصلبة، وشفافيةٌ في المعايير، وتراكمٌ في الخبرة، ومحاسبةٌ تربط النتيجة بالخطة لا بالدعاية.
السؤال الثقيل الذي يفتحه الموقف هنا، يتعلق بالبنية الحافظة للاستمرارية أكثر مما يتعلق بالجيل المتوَّج. الحفاظ على المنحنى الصاعد يحتاج إلى تأمين «سلسلة القيمة» كاملةً: كشف مبكّر لا يميّز إلا بالكفاءة، وجسورٌ مؤسسية بين المدرسة والملعب، وتحمي التعليم من أن يكون خصماً للتكوين، وطبُّ يضمن أن تُدار الأجسام بعلم لا بعاطفة، ومساراتُ انتقالٍ إلى الاحتراف الخارجي تعود بفائدةٍ متبادلة بدل أن تُحوِّل التكوين المحلي إلى خطّ إمدادٍ مجاني.
حين تُضبط هذه الحلقات، يصبح السؤال «متى التتويج القادم؟» أقلَّ وجاهةً من سؤال «كيف نمنع الفجوة القادمة؟». عندها فقط يغدو لقب سانتياغو مِعياراً يُحتكم إليه لا قِمّةً يتيمة، وتتحول لحظة الانتصار من نشيدٍ عابر إلى دليل استعمالٍ طويل الأمد.
الاقتصاد الرياضي
لم تتوقف الموجة عند صافرة مباراة النهاية، فقد ترجمت النتيجة الرياضية نفسها سريعاً إلى حركةٍ في السوق. فبشكل شبه فوري، ازداد الطلب الأوروبي على نجوم منتخب الأشبال، وظهرت تقديراتٌ أولية لارتفاع القيمة السوقية لعدد من العناصر، بما يعني أن «منتج التكوين» انتقل من وعدٍ بالكفاءة إلى أصلٍ قابل للتسويق.
تتجاوز هذه الإشارة فضول الانتقالات المحتملة إلى اكتمال دورةٍ اقتصادية لها بدايتها في الكشف المبكر ومرحلةٌ وسطى من المواكبة البدنية والنفسية وطب رياضي وقراءة البيانات، وتنتهي في واجهةٍ تسويقية وقانونٍ واضح يحمي القاصرين ويؤطر العقود ويحفظ حقوق التكوين.
عند اكتمال هذه الحلقة، لا تعود «الموهبة» صفةً أخلاقية، بل تصير تسميةً لأصلٍ اقتصادي تتقاسمه الأندية والمنتخبات وسوق العمل الرياضي، وتنتفع منه سلاسلُ موازية من وساطةٍ رياضية وتجهيزات وخدماتٍ رقمية.
لكن الأثر المالي المباشر في أسعار اللاعبين جزءٌ من الصورة لا كلها. فالقيمة الفعلية لنجاعة التكوين تُقاس في أماكن أخرى أيضاً: انخفاض كلفة المخاطرة على ميزانيات المنتخبات حين يصبح الإمداد من الداخل قاعدةً لا ظرفاً، وتراجع فاتورة الأخطاء في الاستحقاقات الكبرى لأن المسار السنيّ يمنح بدائل جاهزة، وارتفاع منسوب التنافس الداخلي بما يُسقط المحاباة ويعيد توزيع الفرص على أساس الأداء لا الاسم، وتحويل جزءٍ من رأسمال الهجرة إلى قيمةٍ مضافة داخل مشروعٍ وطني بدل أن يهاجر صافي العائد بكامله إلى الخارج.
مع تراكم هذه الآثار على دوراتٍ سنوية، تتبدّل ديمغرافيا المهارة في السوق المغربي، ويتراجع خطاب «الانفجار الفردي» لصالح لغةٍ عن إنتاجٍ منتظم يمكن التنبؤ به.
يخلق هذا التحول طلباً نوعياً على مهنٍ محيطة كانت هامشية فأصبحت جزءاً من صلب الصناعة. محلل البيانات الذي يقيس الشدة ويُصوّب الحمل التدريبي، وأخصائي التغذية الذي يضبط مسارات الاستشفاء، والطبيب الرياضي الذي يترجم المؤشرات الحيوية إلى قرارات ميدانية، والمصمم السمعي البصري الذي يحوّل اللقطة إلى منتج تسويقي قابل للتداول، والمسوّق القانوني الذي يحمي الحقوق المعنوية للأندية في آليات التعويض والتضامن…
كل حلقةٍ من هذه الحلقات تُضيف طولاً في عمر الأصل الرياضي وتوسّع مظلة الاستفادة لتشمل مقاولاتٍ صغرى ومتوسطة في التجهيز والنقل والضيافة والخدمات الرقمية.
جيلٌ واحدٌ في ملعبين
لم يكشف التزامن بين كأس العالم للشباب واحتجاجات “جيل Z” عن مفارقة شكلية بقدر ما أظهر تراكب مسارين اجتماعيين لجيلٍ واحد في ساحتين مختلفتين.
في الشارع، تشكّلت لغة مطالب مضبوطة النَفَس تُحدّد السقف في الصحة والتعليم والكرامة ومحاربة الفساد، وتتمسّك بسلميةٍ واعية اشتغلت على الرمز واللافتة والزمن القصير للفيديوهات ومنصّات التنظيم الخفيف عبر التطبيقات.
لم يكن اختيار المفردات اعتباطياً؛ فقد جرى تحييد الشعارات القصوى لصالح عناوين قابلة للقياس، وجرى تفضيل الأساليب التي تُجنّب الاحتكاك وتُبقي المبادرة الأخلاقية لدى المحتج.
في المقابل، قدّم المسار المؤسسي إشارةً موازية بوزنٍ ثقيل: مجلس وزاري برئاسة الملك يُعلن زيادةً نوعية في الجهد الميزانياتي للقطاعين الاجتماعيين الأكثر حساسية، ويُطلق خارطةً تنفيذية تمتد من المستشفيات الجامعية وإعادة تأهيل الشبكات الصحية القائمة إلى تسريع إصلاح المدرسة عبر تعميم التعليم الأولي، ودعم النجاح المدرسي، وتحسين الجودة.
هذا التوازي يقول إن الرسالة لم تبقَ أسيرة فضاء واحد، وإن جزءاً من «إدارة اللحظة» تحوّل فعلاً إلى سياسةٍ عمومية قابلة للتنفيذ، ما يجعل من مواءمة السياسة الجنائية مع الإيقاع نفسه حلقةً لازمة في الصورة النهائية حتى لا يعلو لحنٌ قديم على إيقاعٍ جديد.
في هذا السياق يخرج سؤال الثقة من العموميات إلى التفاصيل العملية. فالثقة لا تُبنى بالصور المدوية ولا بالبلاغات المطمئنة وحدها، بل بتناسق الإشارة عبر القطاعات. أي كيف تتكلم الدولة اللغة نفسها في القصر والبرلمان والشارع والمحكمة؟
حين تستقيم الرسالة المؤسسية في إيقاعٍ واحد، تتحوّل لحظة التتويج من حدثٍ عاطفي إلى أصلٍ اجتماعي. معنى الأصل هنا أنه قابل لإعادة الاستثمار: يُترجم في تعبئةٍ إيجابية حول الإصلاحات، وفي استعدادٍ مدني للتعاون مع سياساتٍ موجّهة، وفي خفضٍ لتكلفة الاحتجاج ذاته لأن قنوات الاستجابة أصبحت موثوقة.
أمّا حين تتضارب الإشارات، فإن الكأس، مهما كان بريقه، يظل معزولاً في ألبوم الذكريات، ويغدو الاستثناء الجميل ستاراً مؤقتاً على سياقٍ مرتبك. لذلك يصبح توحيد النغمة بين التتويج الذي يقول «نثق بكم ونستثمر فيكم»، وبين سياسةٍ جنائية تقول الشيء نفسه في لغة الإجراءات، شرطاً لتمتين العقد الاجتماعي الجديد الذي لمّحت إليه مشاهد الرباط.
معادلة الفرجة والمساءلة
لم تولد الدعوات الشبابية إلى مقاطعة مباريات المنتخبات الوطنية من نزقٍ عابر، بل من إحساسٍ بأن لغة الأولويات قد اختلّ ميزانها، وأن صورة الاستثمار في الملاعب لا تُرى معها خرائطٌ مفصلة لمستشفى ومدرسة وخدمة عمومية قريبة.
مع ذلك، جرى الحرص في خطاب المقاطعة على تثبيت ثنائية لافتة: دعم المنتخب وحبّ الوطن من جهة، واعتبار المدرّجات الخالية رسالةً احتجاجية من جهة ثانية. في المقابل، تبلورت مقاربةٌ لا تُنكر هذا الحق ولا تُجرّمه، لكنها تقترح طريقاً ثالثاً أقلّ كلفة وأعلى مردوداً: أن يُحوَّل الحدث الرياضي، وقد صار واقعاً بعقودٍ موقّعة وجداول إنجاز وسلاسل تمويل وتشغيل مترابطة، إلى مختبرٍ حيّ للحكامة.
بهذا المعنى لا تُختزل المسألة في سؤال الحضور أو الغياب عن المدرجات، بل في القدرة على تحويل التظاهرات الكبرى من «مشهدٍ يعلو» إلى «منصّة تُسائل»، ومن إنفاقٍ لا يُرى أثره إلى سلسلة قيمةٍ شفافة تُقاس حلقةً حلقة.
يستقيم هذا البديل الثالث حين يتقدّم المجتمع بأسئلته الثقيلة في توقيتها الصحيح وبصيغٍ قابلة للترجمة المؤسسية.
لا يكفي التلويح بشبهةٍ عامة، بل المطلوب جعلها قابلـة للقياس. أين توجد لوائح الصفقات مفصّلة ومفتوحة المصدر، وتُنشر الكلفة، وتعلن الآجال، وتظهر هوية المتعهدين من الباطن؟
أسئلة المرحلة هي ما حصة المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية ضمن سلاسل التوريد؟ وكيف تُصمّم دفاتر الشروط بما يضمن الولوج العادل وعدم تركيز السوق في يد قلة؟ وأين تُنشر عقود الالتزام البيئي وخطط التخفيف من البصمة الكربونية، ومعها مؤشراتٌ دورية لمراقبة استهلاك الماء والطاقة وإدارة النفايات؟ وما هي خطط «الإرث» لكل مدينة بعد الحدث؟ وكيف تُترجَم إلى استعمالٍ منتظم للملاعب والمنصات في الرياضة المدرسية والجامعية والرياضات القاعدية، بدل تحوّلها إلى أصولٍ خاملة؟ وكيف تُحجز في العقود نسبٌ صريحة من مداخيل الرعاية، وحقوق البثّ تخصص لصناديق اجتماعية محددة الوجهة والحكامة، بحيث يمكن تتبّع كل درهم من مصدره إلى أثره؟
حين تُطرح هذه الأسئلة بوصفها مطالب تشغيلية لا شعاراتٍ أخلاقية، تُجبر الأجهزة المنظِّمة على إنتاج بياناتٍ قابلة للتدقيق، ويصبح فتح بواباتٍ للمعطيات الضخمة جزءاً من معايير النجاح لا ترفاً تواصلياً.
عندها فقط تتحوّل «الفرجة» إلى أداة مساءلة؛ تذاكر تُوفَّر للفئات الهشّة وفق صيغٍ اجتماعية واضحة، ومقاعد تُخصّص للشباب والطلبة عبر قنوات عادلة، وعقودُ شغلٍ تلتزم أجوراً لائقة وتأميناتٍ واحتراماً لمدوّنة الشغل بدل تشغيلٍ هشّ مؤقّت.
ويجد مبدأ «الشراء المسؤول» مكانه في دفاتر التحملات، فتُقدَّم الأفضلية للمورّدين الملتزمين والذين أنتجوا أثرَاً اجتماعياً وبيئياً مثبتاً، ويجري التعاقد مع الجماعات الترابية على عقود أداء تتضمن مؤشراتٍ نصف سنوية تُنشر للعموم حول نسب إنجاز الأشغال والأثر المحلي على الشغل والتجارة الصغرى.
في هذا الإطار يصبح الفوز الرياضي رافعة لا ستاراً. فكل مباراة ناجحة تُضاعف شرعية المطالبة ببياناتٍ أدقّ، وكل صورة احتفالٍ تُلزم بصفحةٍ محاسباتية تُنشر، وكل نجمةٍ على القميص تُذكّر بأن النجاحات الرمزية لا تعيش طويلاً إن لم تسندها مؤسساتٌ تتكلم اللغة نفسها: لغة الأثر، والشفافية، والتوزيع العادل.
عندها فقط يفقد الانقسام ثنائيته العقيمة بين مقاطعةٍ وتصفيق، ويُعاد توجيه الطاقة الشبابية إلى حيث تُنتج فارقاً ملموساً: تحويل الحدث إلى امتحان علني لجدوى الإنفاق، وإلى مدرسةٍ عملية لسياساتٍ عمومية ترى المواطن لا متفرجاً فحسب، بل شريكاً يملك الحق في المعلومة والقدرة على المتابعة وأدوات الاعتراض حين يلزم.
ما تحقّق وما ينقص
على امتداد العقد الأخير، تبدّلت صورة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من جهاز يطفئ الحرائق إلى مؤسسة تضبط الإيقاع. وانتقلت فلسفة العمل من مبادرات متباعدة إلى هندسةٍ متكاملة للمنتخبات والفئات السنية، وتوسّع الاستثمار في مراكز التكوين والإيواء والتغذية والتأهيل، وتعزّزت معايير المواكبة الطبية والبدنية، وصار جمع البيانات وتحليلها جزءاً من القرار لا ملحقاً تجميلياً له.
هذا التحوّل رسّخ ما يمكن تسميته «عمود المنتخب الفقري»: منظومة اختيار وانتقاء ومرافقة تسمح بالوصول إلى الأداء العالي حين يُستدعى اللاعب للقميص الوطني. غير أنّ الجهة الثانية من الصورة لا تزال أقل اتساقاً؛ فالفجوة بين هذا العمود وبين قاعدة الأندية بقيت قائمة، بما يحول دون تحويل دينامية المنتخب إلى إنتاجٍ محلي غزير ومستدام للمواهب.
جوهر الفجوة ليس نصّ «الشركات الرياضية» في ذاته، بل الفرق بين عنوانٍ قانوني وإصلاحٍ ملموس. المقصود إدارة محترفة تُمسك بدفاتر التعاقدات والحكامة الداخلية والشفافية المالية، وتسويقٌ يخرج من منطق العائد الموسمي إلى بناء علامةٍ تجارية للنادي، وحقوقُ بثّ تُدار مركزياً بعقودٍ واضحة وآليات توزيع عادلة تُراعي قاعدة المشاهدين والنتائج والتنقيط المالي، وبرامجُ تكوينٍ للمسيّرين تجعل القرار الاقتصادي في مستوى القرار التقني.
حين يستمر النادي أسيرَ ميزانيات هشة وديونٍ متراكمة وتدبيرٍ يوميّ بلا رؤية، يصبح الاعتماد على «استيراد الحل» من منتخبٍ قوي أو من محترفين قادمين من الخارج إغراءً دائماً لا شريكاً مؤسِّساً. وحين لا تُقاس الأندية بمؤشراتٍ دورية للجودة والبنية والتكوين وحماية الأجراء واحترام آجال الأداء، يُفرّغُ شعار الاحتراف من معناه، وتتعطل الحلقة الأهم في السلسلة القيمية: إنتاجٌ محلي منتظم يقلّص المخاطرة ويرفع سقف المنافسة الداخلية.
عند هذا المستوى، لا يعود النقاش حول «المال» سجالاً أخلاقياً، بل أداةً لتقليل المخاطر ورفع جودة المنتج المحلي، بما يُغني المنتخب الوطني عن الإفراط في الاعتماد على رأسمال المهجر، ويجعل حضوره مكمّلاً لا بديلاً.
ويمرّ التحدّي الموازي عبر مأسسة العلاقة مع شبكات اكتشاف المواهب الأوروبية، ومع بيئات «الدياسبورا» التي تمدّ المغرب بمواهب صُقلت في مدارس عالية التنافس.
كلما كانت بروتوكولات الانتقاء واضحة، وانعكست في اتفاقيات إطار تضمن الحقوق المادية والمعنوية للأندية والمؤطّرين المحليين عبر تعويضات التكوين ونِسب التضامن، تراجعت الاحتكاكات التي تولّد سوء الفهم حول «استقدام أسماء» بدل «بناء كُتلة تنافسية».
المطلوب هو وضع سجلاتٌ وطنية محدثة لمسارات اللاعبين منذ الفئات الصغرى تتيح تتبّع «سلسلة القيمة» من أوّل حذاء يُشترى إلى أول عقدٍ يُوقَّع، وآلياتُ تسوية سريعة للنزاعات على غرار غرف فض المنازعات الرياضية، ونُظمُ حماية للقاصرين تراعي قوانين الإقامة والدراسة ولمّ الشمل، ومذكرات تفاهم مع اتحادات أوروبية حول تبادل البيانات الطبية والبدنية ضمن ضوابط الخصوصية.
بهذه التفاصيل الصغيرة التي تُصنع في الكواليس، تتحوّل «ثقافة الفوز» من شعارٍ معلق على الجدار إلى قياساتٍ يومية داخل الأكاديميات وغرف العلاج ومكاتب المحاسبة، وتغدو قيمة اللاعب نتاجَ منظومةٍ محلية وواجهةٍ خارجية في آنٍ واحد.
حين تُحسم هذه المنظومة العملية، يصبح لِـ«المنتخب القمّة» قاعدةٌ تُغذّيه ولا تستنزفه. دوري شبّان بمستوى تنافسي عالٍ مرتبط زمنياً وفنياً برزنامة المنتخب، وطبٌ رياضي ومختبرات أداء تخدم الأندية كما تخدم الفِرق الوطنية، وحكّامٌ محترفون يطوَّرون ضمن مسارٍ مهني واضح، وكرةٌ نسوية تُمنح مساحتها التمويلية والهيكلية، ورزنامةٌ موحّدة تُراعي راحات اللاعبين وتقلّص ازدحام المباريات.
عندها يصبح العشب المحلي تربةً خصبة تُنبت المواهب و”تبيعها” في المرحلة المناسبة دون أن تفرّط في عائدها الاجتماعي والرمزي، ويتحوّل الاعتماد على رأسمال المهجر من ضرورةٍ هيكلية إلى خيارٍ استراتيجي يزيد التشكيلة عمقاً وتعدداً، لا عكّازاً تُبنى عليه كل الحكاية.
الإرث من الملعب إلى المدينة
يظل الفارق الحاسم بين تظاهرةٍ تُسجِّل اسمها بشكل عابر على خطّ الزمن، وأخرى تُعيد رسمه؛ هو ما تُخلّفه وراءها من أثرٍ قابلٍ للقياس.
الإرث هنا لا يساوي ملعباً أنيقاً يلمع في الصور، بل منظومة استغلال ما بعد الحدث تُحوِّل البنية من كلفةٍ استثنائية إلى أصلٍ مُنتِج. الأصل هو عقد تشغيلٍ دائم يربط الملعب بشبكة الحياة الحضرية: أي رزنامة سنوية تضمن تنويع الفعاليات بين الرياضة والتكوين والمؤتمرات والثقافة، ومركز خدماتٍ محيط يشتغل على مدار السنة ويُولِّد مداخيل ممتدة من الضيافة والتجزئة واللوجستيك، ومخطط صيانة ممول مسبقاً لا يُترك رهينة مزاج الميزانيات.
حين تتوافر هذه العناصر، يفقد السؤال الدفاعي التقليدي عن “جدوى الملعب” ثقله، لأن المنشأة تتحول من بند إنفاق إلى ماكينة قيمة مضافة.
يبدأ هذا الإرث النافع قبل صافرة الافتتاح. والتجارب المقارنة تُظهر أن المدن التي تربح بعد أن تنطفئ الأضواء هي التي قطعت تعاقداً مُعلنًا منذ اليوم الأول، يحدد المؤشرات التي سيُحاسَب عليها الجميع.
مؤشرات من قبيل نسب الذهاب والإياب عبر النقل العمومي، وربط الأحياء الهامشية، وحصة الشركات المحلية الصغرى والمتوسطة في سلاسل التوريد، ونسبة الوظائف الدائمة مقارنة بالمؤقتة، ومعدلات استعمال المنشآت خلال الأسابيع والأشهر غير النشيطة… وجود هذه المؤشرات ليس ترفاً إجرائياً؛ بل هو ما يحوّل الإرث من ادعاء إلى التزام، ويمنح المجتمع أدوات متابعةٍ دورية تمنع انزلاق المشاريع إلى خانة “التحفة المعمارية المعطلة”.
في السياق المغربي، يبدو التحدي مزدوجاً: تثبيت إرثٍ محلي حيث تقع المنشآت من جهة، وتجسير الأثر نحو المدن التي لم تنل نصيبها من الاستضافة من جهة ثانية.
معيار القياس إذن لا ينبغي أن يتوقف عند سرعة إنجاز ملاعب “الكان” و“المونديال”، بل ينبغي أن يمتد ليجعل هذه السرعة نفسها قانوناً يُعمَّم على المستشفيات والمدارس وتجهيزاتها في المدن غير المونديالية.
عندما تُدار منظومات الصحة والتعليم بمنطق جداول الإنجاز، وسلاسل التوريد المنضبطة، ولوحات قيادةٍ منشورة تشبه ما اعتمدته مشاريع الملاعب، سيتراجع تلقائياً خطاب “الأولوية التي تلتهم باقي الأولويات”.
“العصا السحرية” التي تشتغل لصالح الملاعب قادرة على أن تشتغل للفصول الدراسية وغرف الإنعاش إذا وُضعت القواعد نفسها واحترمت، وإذا مُنحت فرق التنفيذ، التفويض والضمانات عينها.
ولكي يترسخ هذا المنطق، يجب نقل «حكامة التظاهرة» إلى «حكامة المدينة»، من خلال مجلس محلي ينشر محاضر التتبع شهرياً، وهيئة مستقلة للتدقيق تراقب التزامات التشغيل والصيانة والشفافية، وعقود إدارةٍ تتضمن بنود أداءٍ جزائية ومكافآت مرتبطة بالنتيجة، وسياسات تسعيرٍ متدرجة تضمن الولوج العادل للفضاءات العامة بدل احتكارها من قبل أقلية قادرة على تحمّل الكلفة.
لا يثبت الإرث الاجتماعي بالضرورة في الأرقام الكبرى وحدها، بل في التفاصيل التي تمسّ الحياة اليومية: مساراتٌ آمنة للمشاة والدراجات تصل الأحياء بالمنشأة، ومكتباتٌ ومختبرات رقمية داخل المجمعات الرياضية تفتح أبوابها للتلاميذ خارج أوقات المباريات، وبرامج تكوينٍ مهني معتمدة تُخرج جيلاً من مديري التظاهرات والتقنيين وحراس السلامة الرقمية والبثّ…
هكذا فقط تنتقل التظاهرة من فخرٍ ظرفي إلى سياسةٍ حضرية. أي عندما يجد المواطن في مدينته بعد الحدث ملعباً متعدد الوظائف، وخط نقلٍ يوصله صباحاً إلى عمله، وفرص تدريبٍ قريبة، ومساحات عمومية تُستعمل بكثافة، تتغيّر اللغة من “كم أنفقنا؟” إلى “ماذا ننتج كل عام؟”.
وعندما تتكافأ هذه الصورة مع تسريعٍ موازٍ في المدرسة والمستشفى، تفقد المقولة الشائعة عن أولويةٍ تبتلع باقي الأولويات قوتها، لأن الجدول سيُظهر أن المنظومة نفسها قادرة على الإنجاز حيثما وُضعت القواعد وجرى احترامها، وأن الإرث الحقيقي هو تَملُّك طريقة عملٍ لا تنطفئ بانطفاء الأضواء.
مرآة لا قناع
تُظهر لحظة تتويج «أشبال الأطلس» أنّ الفوز لم يهبط مصادفة من سماء الرياضة، بل تشكّل حين صارت الكفاءة قراراً عمومياً لا ومضة فردية. حين تُدار الفرصة وفق قواعد عادلة وشفافة، يتراجع أثر الحظ، وتبرز اليد الخفية للمؤسسات: انتقاءٌ مبكر يحميه معيار لا مزاج، وتكوينٌ مؤطر بعلوم الأداء لا بشعارات الحماس، سُلّم حوافز يربط المجهود بالإنصاف، وحكامة مالية وتنظيمية تُعلن التزاماتها وتقبل المراجعة. في هذا المناخ لا يعود اللاعب الاستثنائي عذراً لإخفاء هشاشة المنظومة، بل يصبح ثمرةً عادية لشجرةٍ تُسقى بانتظام.
وينعقد المعنى الأبعد عندما تتسق إشارات الدولة عبر فضاءاتها المختلفة. استقبالٌ أميري يكرّس رمزية الجيل ويعترف بثمرات التكوين، وبرنامج اجتماعي يرفع الجهد في الصحة والتعليم ويضع الجِدّية على المحك، وسياسة جنائية منضبطة بروح الدستور تمنع انقلاب رسالة الاحتفاء إلى إيحاء بالريبة.