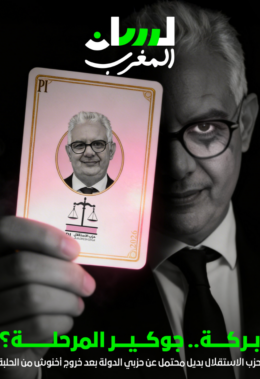سيون أسيدون.. سيرة رجل خرج من كل الهويات الضيقة ليبقى في صفّ الإنسان

صباح الجمعة السابع من نونبر 2025، أسلم سيون أسيدون الروح بعد ثلاثة أشهر من غيبوبة أعقبت حادثا داخل منزله بالمحمدية. حادث ما زالت ظروفه موضوع تساؤل قانوني وحقوقي مشروع.
قرار نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لإجراء خبرة دقيقة، لا يندرج في خانة الإجراءات الشكلية فحسب، بل يعد امتدادا طبيعيا لمسار رجل بنى جزءا من شرعيته الرمزية على المطالبة بكشف الحقيقة كاملة في كل القضايا التي مست الكرامة الإنسانية والمال العام والقضية الفلسطينية.
بالنسبة لسيون أسيدون، الذي كرّس حياته لمواجهة التزييف المؤسسي والتواطؤ الصامت، سيكون دفنه تحت سماء شفافة ومكتملة المعطيات أبلغ تكريم ممكن. على أن ما ستقوله تقارير الطب الشرعي اليوم، أيا كان مضمونه، لا يلغي حقيقة أساسية: حياة هذا الرجل، بسيرتها المتصلة منذ أواخر الستينيات إلى لحظة سقوطه الأخير، قدّمت رواية مكتملة عن اتساق نادر بين الفكر والموقف، وبين الانتماء والمبدأ.
ميلادٌ على حافة زلزالين
ولد سِيون أسيدون في أكادير سنة 1948؛ سنة إعلان قيام الكيان الصهيوني على أنقاض فلسطين، وفي عتبة عقد ستعرف فيه البلاد أول المنعطفات الحادّة في تاريخها الحديث.
يهودي مغربي من أسرة قادمة من آسفي، نشأ في مدينة بلا غيتو ولا أسوار، في أحياء مختلطة لا تطرح فيها أسئلة الهوية الدينية قبل التحية اليومية، وحيث يبدو التعايش حالة عادية لا شعارا سياسيا.
اسمه نفسه، كما كان شرح لنا في برنامج “ضفاف الفنجان”، يحمل أثر الجذر الأمازيغي: “أسيدون”، أي الرابط؛ وكأن قدر صاحبه أن يقضي عمره يحاول إعادة وصل ما جرى فصله قسرا: بين اليهودية والمغربية، بين النضال الوطني والقيم الكونية، بين فلسطين وضمير العالم، وبين الدولة ومواطنيها.
خلال طفولته، رأى بأم عينيه تظاهرات الاستقلال، ثم زلزال أكادير الذي انتقل به من براءة الطفولة إلى وعي مبكر بهشاشة العمران والبشر معا. ثم انتقل بعد الكارثة مع عائلته إلى الدار البيضاء، وتحديدا إلى مدرسة فرنسية وفضاء اجتماعي جديد، حيث ظهر للمرة الأولى ذلك التناقض بين خطاب المساواة الرسمي وممارسات التمييز والاستعلاء الاستعماري، ثم إلى كشافات يهودية كانت الدعاية الصهيونية تحاول عبرها رسم وطن بديل في مكان آخر.
هناك، كان المسار ممهّدا لأن يلتحق بركب من حملوا تذكرة الهجرة وبندقية الجيش الإسرائيلي؛ لكن فكرة بسيطة حاسمة أوقفت الانزلاق: الإيمان بالمساواة لا “الاختيار”، بالإنسان لا “الشعب المختار”. من هنا بدأ انفصاله الهادئ عن الرواية الصهيونية، وترسخ انتماؤه المزدوج: يهوديا مغربيا يرى في فلسطين قضية عدالة لا موضوع دعاية، وفي وطنه الأول أرضا لا تستبدل.
من ماي 68 إلى “لنخدم الشعب“
في فرنسا، حيث سافر لدراسة الرياضيات، وجد سِيون أسيدون نفسه في قلب زمن سياسي مضغوط: حرب فيتنام، نكسة 1967، انتفاضة ماي 1968. وفي مدرجات الجامعات التي كانت جدرانها تردّد “فييتنام ستنتصر”، اكتشف يسارا جديدا يعيد تعريف العلاقة مع الإمبريالية، ويفكك الروايات الجاهزة، ويضع فلسطين في موضعها الحقيقي: قضية استعمار واستيطان، لا ملحقا بخطاب ديني أو سردية ضحية أبدية.
هناك بدأ يقرأ، بهدوء منهجي، المصير الفلسطيني خارج الدعاية الصهيونية التي رافقته في طفولته، ويعيد ترتيب موقعه هو في هذه الخريطة.
حين عاد إلى المغرب، لم يعد طالب رياضيات فقط؛ عاد بقناعة صلبة بأن الاستقلال لم يكتمل، والعدالة الاجتماعية غائبة، والديمقراطية منقوصة، وأجهزة الدولة تتحول إلى بنية مسيطرة أكثر منها إطارا تعاقديا.
انخرط أسيدون في ما سيعرف لاحقا باليسار الجديد، ضمن تجربة “لنخدم الشعب”، في محاولة لإنتاج معارضة راديكالية نظيفة اليد، تؤسس لمشروع تغيير جذري في بلد خرج لتوه من زمن الاستعمار ودخل سريعا في منطق الحكم الأمني.
لم يكن يحمل سلاحا، بل كان يحمل منشورات وأسئلة وأفكارا. لكن في مغرب أوائل السبعينيات، كان هذا وحده كافيا لوضعه في خانة “الخطر على أمن الدولة”. اعتقل، ونقل إلى “دار المقري” حيث تعرّض لأبشع أساليب التعذيب التي سيصفها لاحقا ببرودة الوقائع: “الطيّارة”.. التعليق.. الصعق.. الإيهام بالغرق… ثم أحيل إلى محاكمة سياسية بتهمة “التآمر لقلب النظام”، وقضى أكثر من اثنتي عشرة سنة بين الاعتقال والعزلة في السجن المركزي بالقنيطرة.
لم تخلّف تلك التجربة مناضلا مكسورا، أو ثأريا متعطشا للانتقام؛ بل صقلت قارئا منهجيا، وذاكرة دقيقة، وفهما مركّبا لبنية الاستبداد. تعلّم أن يفرّق بين الجلاد كموظف في آلة، وبين المنظومة التي تنتجه وتحميه، بين الرغبة في القصاص وبين مطلب العدالة.
لذلك، حين خرج إلى الضوء، لم يتجه إلى تسوية مع السلطة ولا إلى مقعد مريح في الهامش؛ بل عاد مباشرة إلى الشارع، وإلى قضايا الفساد، وإلى فلسطين، وإلى المعارك التي لا تحتاج إلى ترخيص كي تعلن عن نفسها.
لا حقد ولا مساومة
منذ منتصف الثمانينيات، صار سِيون أسيدون واحدا من تلك الأصوات القليلة التي رافقت “الانفتاح” المغربي بلا أوهام. خرج من السجن من دون طلب تعويض، لأن “ما ضاع لا يشترى”، كما كان يردد، ومن دون سعي إلى مقعد في المؤسسات الناشئة فوق ركام “سنوات الرصاص”، ولا قبول بدور شاهد صامت على مصالحة ينجزها الأعلى باسم من دفعوا ثمنا في الأسفل.
اختار مسارا أكثر كلفة وأقل مردودية شخصية: التمسك بمعيار حقوق الإنسان في تقييم التحول السياسي، والانخراط في معركة تجريم الفساد باعتباره بنية إنتاج للسلطة والثروة لا مجرد انحراف فردي، ثم توسيع جبهة نضاله نحو فضح المشروع الصهيوني وقيادة دينامية المقاطعة (BDS) في نسختها المغربية والعربية، بوصفها امتدادا طبيعيا لمعركة العدالة في الداخل لا ملفا خارجيا معزولا.
في زمن أعاد فيه كثيرون ترتيب علاقتهم بالدولة وفق ميزان الربح والخسارة، ظل أسيدون وفيا لثلاث قواعد بسيطة تحكم اختياراته:
- لا عدالة بلا حرية: أي لا ديمقراطية مع التعذيب، ومع الاعتقال التعسفي، ومع محاكمات تدار بالهاتف لا بالقانون.
- لا سيادة مع الفساد البنيوي: أي أن تجفيف منابع الرشوة واستغلال النفوذ شرط من شروط بناء دولة حديثة، لا مجرّد ورش إداري أو تقنية حكامة.
- لا كرامة مع التطبيع: أي لا معنى لخطاب الاستقلال الوطني فيما تفتح، في الآن نفسه، منافذ أمام مشروع استعماري استيطاني ينكر حق شعب آخر في الأرض والحياة.
جعله هذا الاتساق الأخلاقي حالة نادرة: يساريا جذريا من دون تعصّب عقائدي، متدينا بحقوق الإنسان لا بهوية مغلقة؛ مستعدا للجلوس مع الإسلاميين واليساريين والليبراليين في المسيرة نفسها، بشرط واحد واضح: أن يكون موقفهم من الاستبداد والاحتلال والظلم محسوما لا رماديا.
كسر جميل للصورة النمطية
في سنوات “تسونامي التطبيع”، عندما جرى استدعاء “المكوّن العبري” في الهوية المغربية كذريعة ناعمة لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، كان سِيون أسيدون من القلائل الذين أعادوا ترتيب المفاهيم قبل الشعارات. ذكّر، بهدوء حازم، بأن اليهودية ديانة وجماعة تاريخية متجذرة في هذا البلد، وليست مشروعا استعماريا عابرا للحدود، وأن يهود المغرب لم يكونوا عبريّي اللسان ولا جسورا للاختراق، بل ناطقين بالدارجة والأمازيغية، مندمجين في النسيج الوطني، يحملون همومه ويتقاسمون مصيره.
في مقابل ذلك، وضع الصهيونية في مكانها: حركة سياسية كولونيالية، لا تختزل اليهود ولا تمثلهم جميعا، ولا يجوز تبييض سجلها بعبارة “مكوّن عبري” تستخرج من سياقها التاريخي لتشريع شراكات عسكرية وأمنية واقتصادية مع نظام احتلال وفصل عنصري.
قدّم، بوصفه يهوديا مغربيا، البرهان الأكثر قوة على هذا الفصل الضروري: إيمان شخصي وديني وثقافي لا يتعارض مع رفض جذري وأخلاقي للمشروع الصهيوني.
كان يجمع، في المشهد نفسه، الطربوش المغربي والشال الفلسطيني، دون استعراض هوية مركّبة، بل كبيان عملي: أن مناهضة الصهيونية ليست معاداة للسامية، بل دفاع عن حدّ أدنى من العدالة، وأن الانتماء لليهودية لا يلزم صاحبه بتبني احتلال ولا حصار ولا قصف أطفال. بهذا الوضوح، حمى النقاش المغربي من فخ الخلط المتعمد بين نقد إسرائيل والتحريض على اليهود.
لذلك، حين نعاه سفير فلسطين، وقيادات يسارية، ووجوه من الحركة الإسلامية، وعلماء دين، ومنظمات حقوقية، لم يكن ذلك احتفاء فلكلوريا بـ”اختلاف جميل”، بل اعترافا مشتركا بندرة نموذج حافظ على المعايير نفسها في كل الاتجاهات: لا للتعذيب هنا، لا للاحتلال هناك؛ لا لتبييض الاستبداد باسم الواقعية السياسية، ولا لتبييض الاستعمار باسم “الشراكة الاستراتيجية”.
“BDS” وضمير المغرب
لم يكن سِيون أسيدون “ناشط هاشتاغ” ولا خطيبا يكتفي بالاستعارات النارية. كان رجل ملفّات وأرقام ووثائق، يشتغل في المنطقة التي تفضح الشعارات الفارغة: أسماء شركات، مسارات أموال، عقود شراكة، صفقات تسليح، خطوط توريد، وروابط مباشرة بين الربح الخاص والدم الفلسطيني.
تفكيك شبكات التغلغل الاقتصادي الإسرائيلي لم يكن عنده عنوانا فضفاضا، بل عملا دؤوبا: تتبّع الشركات المتورطة في الاستيطان أو في تزويد آلة الحرب بما تحتاجه، ورصد استثمارات تمر عبر الواجهات أو الأراضي الثالثة، وكشف الصيَغ “القانونية” التي تستعمل لتسويق التعاون مع منظومة الأبارتهايد.
شارك أسيدون، مع رفاقه، في حملات دولية ووطنية انتهت إلى انسحاب شركات متعددة الجنسيات من مشاريع تخدم الاحتلال، واعتبر المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية شكلا متقدما من المقاومة المدنية، يربط بين ضمير المستهلك ومسؤولية الدولة وقواعد القانون الدولي.
أزعج حكومات، وأحرج مؤسسات، وأربك شركات كانت تراهن على ضبابية المعلومات وصمت الداخل. ومع ذلك، لم يشتغل يوما بمنطق التحريض الأعمى أو الكراهية الهويّاتية؛ كان يستند إلى مرجعيات واضحة، هي القانون الدولي الإنساني، ومنظومة حقوق الإنسان، ومبدأ بسيط لا يحتمل الالتباس: من يحتل أرضا، ويحاصر شعبا، ويهجّره بالقوة، لا يعامل كشريك “طبيعي”.
في حوارنا معه في “ضفاف الفنجان”، لخّص الهدف دون زخرفة: نزع الشرعية عن المشروع الصهيوني عبر ثلاث ركائز مترابطة: إنهاء الاحتلال والاستيطان، وإنهاء نظام التمييز العنصري، وضمان حق العودة.
لم يكن يبحث عن “حل وسط” يساوي بين الجلاد والضحية، بل عن نقطة واحدة تستقيم عندها السياسة مع الأخلاق: أن يتوقف الظلم، وأن تسمّى الأشياء بأسمائها.
تواضع بلا تهاون
جزء من فرادة سِيون أسيدون أنه جمع، في هدوء تام، بين صلابة المناضل الذي لا يساوم على المبادئ، وبين سلوك إنسان خفيض الصوت، متواضع، سريع الابتسامة، منصت أكثر مما يتكلم، حريص على ألا يتحول إلى بطل في حكاية يرويها عن نفسه.
حين كان يتحدث عن التعذيب، يفعل ذلك بلا استعراض لندوب الجسد ولا مزايدة على ألم التجربة؛ يقدّم الوقائع كما هي، لتسجيل المسؤوليات وحماية الذاكرة الجماعية، لا لاستدرار العطف.
وحين كان يستعيد سنوات السجن، كان يتجنب لغة الضحية، ويركز على ما كشفته تلك السنوات من طبيعة السلطة وآلياتها. وحين يصف الخيانات السياسية، يضعها في سياق بنية كاملة لا في خانة تصفية الحسابات مع أفراد.
حتى في مواجهة التطبيع، ظل خطابه بعيدا عن الفاشية اللفظية وعن شيطنة الأشخاص بسبب أصولهم أو هوياتهم. مشكلته كانت مع المنظومات، مع السياسات، مع القرار الذي يحوّل الظلم إلى وضع “طبيعي”.
رفض أسيدون باستمرار تحويل سيرته النضالية إلى عملة للاستهلاك أو إلى بطاقة اعتماد في الفضاء العمومي. وظل يميل تلقائيا إلى الوقوف خارج “الكادر”، فلا يظهر إلا عندما يقتضي الأمر أن يوضح حقيقة، وأن يفضح معطى، وأن يوقّع نداء، وأن يحمل لافتة، وأن يشارك في مسيرة، أو أن يواجه خطابا رسميا يمس جوهر العدالة أو يحاول تجميل جريمة.
بهذا السلوك، كما بمواقفه، حافظ على ما ندر: اتساق بين ما يقول وما يفعل، بعيدا عن الضجيج وقريبا من المعنى.
الغياب الموجع، والحاجة إلى الحقيقة
رحيل سِيون أسيدون ليس سطرا حزينا يضاف إلى أسفل الشاشة، بل لحظة كاشفة لطريقة هذا البلد في التعامل مع الذين قضوا أعمارهم في المطالبة بالحقيقة عندما يصبحون هم موضوع السؤال.
الواقعة التي أدخلته في غيبوبة، والغموض الذي أحاط بملابساتها؛ كلّها ليست تفاصيل طبية أو إجرائية ثانوية. إنها جزء من امتحان بسيط ومباشر: هل تملك الدولة، ومؤسساتها القضائية والصحية، الإرادة لتطبيق أبسط ما دافع عنه هذا الرجل، أي حق المجتمع في أن يعرف، وحق عائلته ورفاقه في اليقين، وحقه هو في ألا يغادر محاطا بالشكوك؟
قرار التشريح، والمتابعة القانونية التي يواصل رفاقه الدفع في اتجاهها، لا يفهمان بوصفهما اتهاما جاهزا أو نزوعا إلى نظرية المؤامرة، بقدر ما يمثلان انسجاما مع الدرس الذي تركه أسيدون نفسه: لا حماية حقيقية لسمعة المؤسسات إلا عبر التحقيق الشفاف، ولا إساءة أعمق للدولة من دفن الأسئلة مع أصحابها.
ورغم الرحيل والتشريح والدفن، يبقى سيون أسيدون نموذجا ليهودي مغربي اختار بوعي ألا يساوم لا على مغربيته ولا على إنسانيته، وأن يضع موقعه الرمزي في الجهة الواضحة من التاريخ: إلى جوار شعب يقصف في غزة ويحاصر في القدس ويطارد في الخليل، دون حاجة إلى أوسمة رمزية أو شهادات “حسن سلوك” من أي جهة، ودون أن يحوّل رفضه للصهيونية إلى مادة للتسويق الذاتي.
يبقى أسيدون سجينا سياسيا سابقا لم يتحول إلى شاهد زور؛ ولم يوظّف تجربة السجن لتغليف خطاب “الاستثناء المغربي”، بل استثمرها في توسيع هامش النقد لسياسات الاستبداد، وفي المطالبة المستمرة بوقف التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبار ذلك شرطا لأي مصالحة حقيقية.
وبقي مناضلا ضد الفساد، ينظر إلى الرشوة والمحسوبية لا كأعطاب أخلاقية معزولة، بل كبنية تمكّن الاستبداد من إعادة إنتاج نفسه، وتعطل إمكان بناء دولة قانون ومساءلة. لذلك ربط بين معركة الشفافية ومحاربة الإفلات من العقاب، وبين جدية أي حديث عن إصلاح سياسي.
وبقي، ربما قبل كل شيء، ضميرا عابرا للخنادق التنظيمية والإيديولوجية؛ وجد فيه اليساريون والإسلاميون، الوطنيون والفلسطينيون، الحقوقيون وبعض علماء الدين، مرجعا مشتركا لاحترام ثابت: الانتصار للضحايا، لا للمعسكرات؛ الوقوف مع المظلوم، أيا كان، وضد الظلم أيا كان مصدره أو اسمه.
لم يكن سيون أسيدون “حالة فلكلورية” ليهودي يهتف لفلسطين في شارع الرباط؛ بل كان مرآة حادّة توضع في وجوهنا جميعا، لاختبار لقدرة هذا البلد على احتضان المختلف حين يكون مستقيمَ الضمير لا مطواعا، وعلى احترام من يقول “لا” حين تستدعيها القيم لا الحسابات، وعلى فهم بديهيته الكبرى: فلسطين، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ليست قضايا متجاورة، بل معركة واحدة ضد المنطق نفسه؛ منطق الهيمنة، داخليا كان أو خارجيا.